لماذا يبدأ شفاء المريض من جودة النظام الصحي لا من الدواء نفسه؟ نشرة التشريعات في أسبوع البريدية - العدد #110 |
| 10 نوفمبر 2025 • بواسطة عبدالعزيز ال رفده • #العدد 110 • عرض في المتصفح |
|
لماذا يعد النِّظام الإلكتروني الرَّكيزة الأولى في صِحة المريض؟
|
|
|

|
| *** |
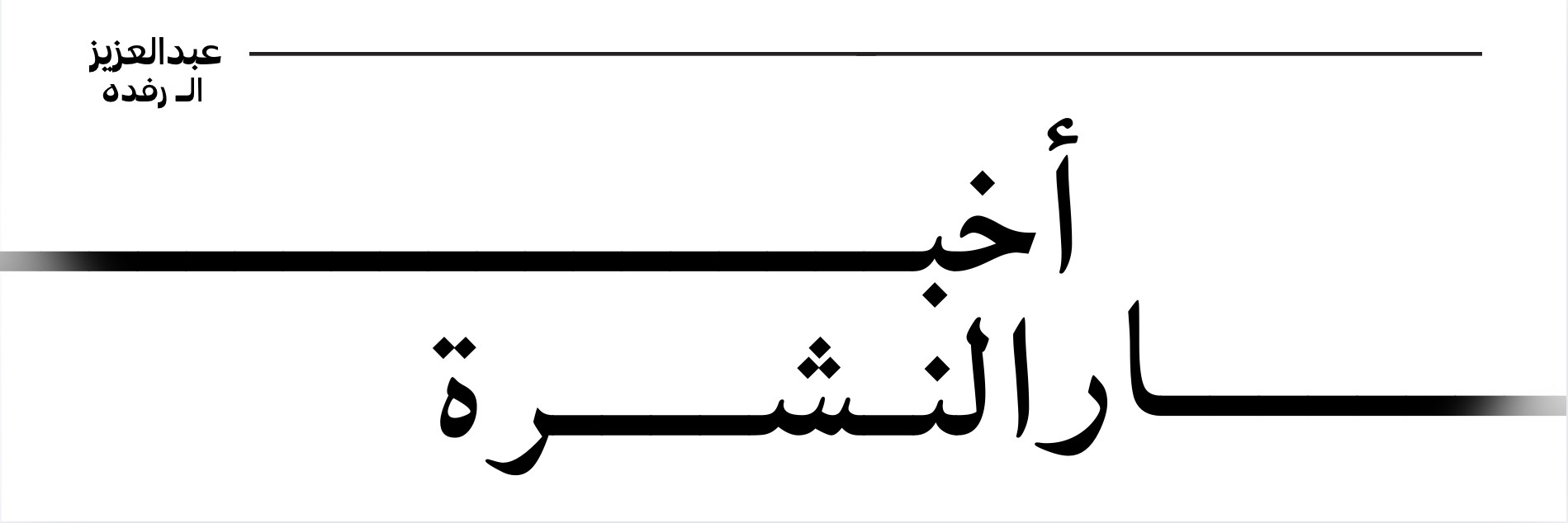
|
إطلاق دستور الأدوية السعودي المرجع الوطني الذي يعزز ريادة المملكة الرقابية عالميًا |
|
دشّن معالي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الأستاذ الدكتور هشام بن سعد الجضعي "دستور الأدوية السعودي Saudi Pharmacopeia" على هامش ملتقى الصحة العالمي 2025 م ، المقام مؤخرا بمركز الرياض للمعارض والمؤتمرات خلال الفترة من 27 إلى 30 أكتوبر. |
|
يمثل الدستور محطة وطنية بارزة في مسيرة تطوير المنظومة الدوائية، إذ يُوحّد مواصفات جودة الأدوية واللقاحات وطرق تحليلها، ويعزز سلامة المنتجات المتداولة وامتثالها لأعلى المعايير العالمية. وقد أوضح الدكتور الجضعي أن المشروع يأتي تتويجًا لدور الهيئة في رفع كفاءة الرقابة الدوائية، بدعم من بنية مخبرية متقدمة تُرسّخ موثوقية الدواء السعودي محليًا وعالميًا. |
|
ويتضمن الدستور فصولًا تخصصية متميزة أبرزها فصل “حلال”، في سابقة على مستوى دساتير الأدوية الدولية، تعكس التزام المملكة بتطبيق المعايير المتوافقة مع الشريعة الإسلامية وتعزيز ثقة الأسواق الإقليمية والدولية بالمنتجات المحلية. |
|
كما يُسهم الدستور في دعم الصناعات الوطنية وجذب الاستثمارات، بصفته مرجعًا تنظيميًا يُسهّل الامتثال ويقوّي برامج التوطين وبناء القدرات البشرية، في إطار مستهدفات رؤية المملكة 2030. ويُعد مرجعًا علميًا للمختبرات والجهات الرقابية وشركات الأدوية، يدعم مسارات البحث والابتكار ويرسخ مكانة المملكة كمركز عالمي في السياسات والتنظيمات الدوائية. |
| *** |
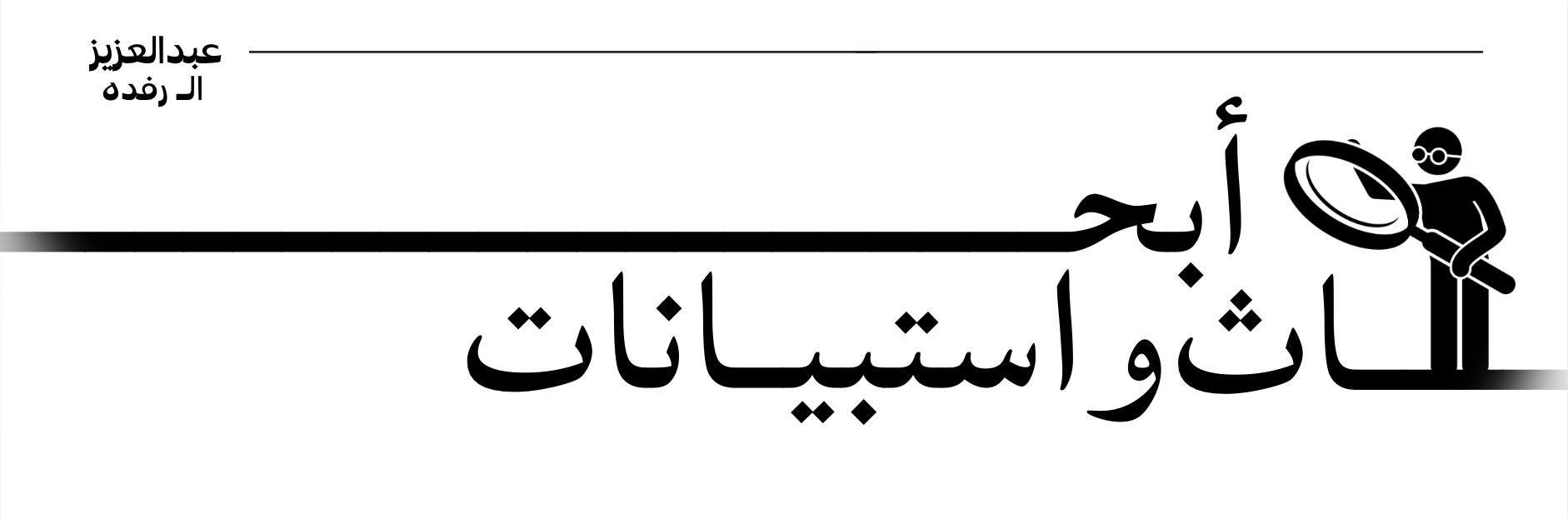
|
أبحاث علمية منشورة 💡 |
|
استبيانات علمية 💡 |
| *** |
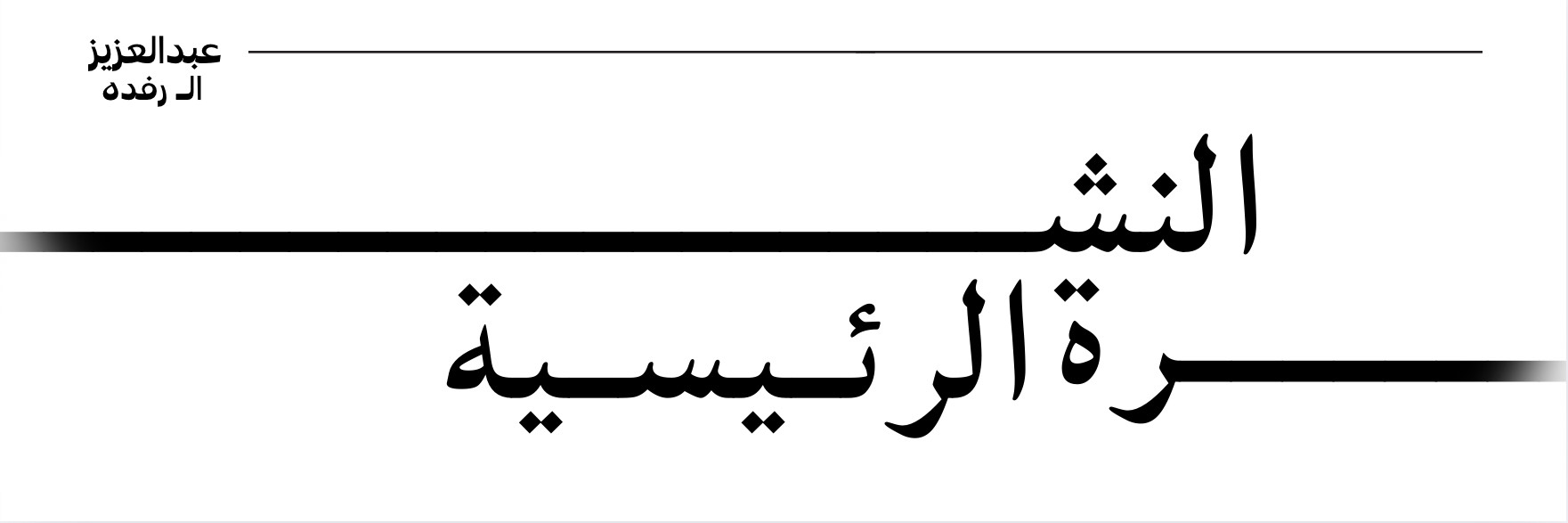
|
|
تخيَّلْ معي هذا المشهد، مستشفى مرجعيّ قرَّر أن نظامه القديم لم يَعُد يُواكِب التغيُّرات الجديدة والطارئة في النِّظام الصحي، فعند سماع الخبر انفتحت شهيّة المطوّرين للأنظمة الإلكترونية من أجل لفتِ الانتباه والتسويق لمنتجهم الذي لا مثيل له في المجال الصحيّ، كلّ ذلك من أجل الحصول على المبلغ الماليّ الذي يسيل له اللعاب قبل وصول يد المنافسين له. |
|
وبالفعل تتمّ ترسية العقد على إحدى الشركات المطوِّرة، وما هي إلّا ليلةٌ وضُحاها، حتى تصدر الأوامر الهرميّة من الرئيس التنفيذيّ مرورًا بالأقسام والمشرفين في المشفى، ليجد الموظفون التشغيليون النظام الجديد أمامهم في أرض الميدان. |
|
في اليوم الأول لانطلاق النظام الإلكترونيّ (Go live)، يتواجد عدد مكثَّف من خبراء التقنية من الشركة المشغِّلة للدعم والمراقبة وإصلاح الخلل إن حدث، لكن ما هي النتيجة؟ |
|
في الحقيقة، أصبح الوضع يُشبَّه بالشلل الذي أصاب المنظومة الصحيّة بأكملها؛ جموع من الممرِّضات ينتظرن دورهن للحصول على الأدوية من الصيدلية، ومرضى تأخرت عملياتهم العاجلة لأكثر من ستِّ ساعات في غرف الجراحة، ومواعيد مراجعين أُجِّلت رغم أنهم قطعوا أكثر من ستمائة كيلومتر للوصول إلى المستشفى. |
|
ولأنه لم تكن هناك خطة بديلة، ظهرت الفكرة القديمة في العودة إلى الورق، وبهذا القرار عاد النظام عقودًا إلى الوراء بدلًا من أن يتقدّم للأمام في اليوم المنشود. |
|
النتيجة الحتمية كانت ضررًا مباشرًا للمريض، وإحباطًا عامًا لدى الموظفين، وشللًا شبه تام في الرعاية الصحيّة، ولم يكن ذلك الحدث ليوم واحد فقط دون غيره، بل تكرّر لأشهرٍ متتالية مع شديد الأسف! |
|
لنطرح سؤالًا مهمًّا هل كانت المشكلة في النظام التقنيّ نفسه؟ أم في الطريقة التي صُمِّم بها واتُّخِذ قراره؟ |
لماذا يكمن الخلل في الأنظمة الهرميّة؟ |
|
تختلف الأنظمة الصحيّة في توجّهاتها، لكن تشترك أغلبها في وجود النظام الهرميّ الذي يضمن توزيع المسؤوليات على أطرافٍ متعدّدة، وغالبًا ما تتفرّع داخله طبقات إداريّة عديدة تُشكِّل شبكة ممتدّة من الأعلى وحتى الأدنى في الصلاحيات الإدارية. |
|
وعندما يُتَّخذ قرارٌ مصيريّ مثل اختيار نظام إلكترونيّ صحيّ دون استشارة من يعملون في الميدان، تُهمَل احتياجاتهم الحقيقية عمدًا أو سهوًا، بل إن وجود النظام الهرميّ قد يُعزِّز مشاعر الرهبة والتنمّر والركون للصمت وعدم إبداء الآراء في الأنظمة الهرمية الأكثر تطرفا. |
|
فعندما يقرّر نظام هرميّ إدارة المستشفى كيفما شاء، باختلاف خبرات القادة وأعمارهم، فإن ذلك يؤدّي حتمًا إلى تراجع جودة الخدمة وتقويض الجهود نحو رحلة مريضٍ مثالية داخل المشفى. |
|
في دراسةٍ وصفيّة أُجرِيت عام 2017 في كندا حول كيفية تعامل أصحاب المصلحة مع النظام الهرميّ، مال 86 مشاركًا من مستويات إداريّة مختلفة إلى أن الأنظمة الهرمية الصارمة تُرهق الموظفين في الميدان وتُقلِّل من فرص الاستدامة، وتُضعِف الدافعية لديهم، وتزيد من نسب الأخطاء التشغيلية. |
|
بينما وجود نظامٍ تشاركيّ يسمع للموظف ويجعله جزءًا من عملية صُنع القرار ثنائية الاتجاه، وُصف لدى المشاركين بأنه أحد أهمّ الخطوات لتحسين جودة العمل في القطاع الصحيّ. |
|
فإذا كانت المشكلة في طريقة التفكير، فكيف يمكن أن تبدو بيئة رقمية تتكامل فيها الأنظمة بدلًا من أن تتنافر؟ |
ما الحل إذن؟ |
|
في عالم التقنية الحديثة، هناك ما يُعرَف بالنظام البينيّ التشاركيّ (Interoperability System)، وهو الذي يوصف بأنه: |
|
قدرة الأنظمة المعلوماتية والأجهزة والتطبيقات المختلفة على التكامل وتبادل المعلومات بسهولة وفي الوقت الفعليّ. تعريف HIMMS لأنظمة التشغيل البينية |
|
حيث تقوم بنية التشغيل البينيّ على أربع مراحل أساسية: |
|
|
ما يميّز هذه الأنظمة أنها شاملة تجمع عدّة قطاعات تحت مظلّة واحدة، ومن أبرز الأمثلة المحلية الناجحة نظام نفيس الذي سيطلقه مجلس الضمان الصحيّ بالتعاون مع المركز الوطنيّ للمعلومات الصحيّة ووزارة الصحة وجهاتٍ أخرى. |
|
يهدف برنامج نفيس إلى تبادل المعلومات الصحيّة والتأمينية للفرد والمواطن، فالمراجع الذي يزور مستشفى حكوميًّا في حفر الباطن سيجد بياناته محفوظة أيضًا في مستشفى حكوميّ آخر في الباحة، وهذا هو جوهر الأنظمة التشغيلية البينيّة. |
|
العائد على المريض واضح في سرعة تبادل المعلومات، وتسريع المطالبات التأمينية، والتحقق من أهلية المستفيدين، ودعم اتخاذ القرار بما ينعكس على كفاءة النظام الصحيّ وجودته، وهو ما ينسجم مع تحقيق رؤية المملكة 2030م في دمج القطاعين الصحي والتقني معا في ثنائية مشتركة. |
ماذا يحدث عندما لا توجد هذه الأنظمة البينيّة أساسًا؟ |
|
في مراجعةٍ بحثية أُجرِيت عام 2023 في جامعة تبريز للعلوم الطبية الإيرانية، شملت 36 دراسة نُشرت بين عامي 2003 و2022، خلص الباحثون إلى أن غياب الأنظمة البينيّة يؤدّي إلى رداءة جودة الخدمة وزيادة الهدر الماليّ والبشريّ. |
|
فقد أشارت الدراسة إلى أن أفضل أشكال التشغيل البينيّ هو التشغيل الدلاليّ (Semantic Interoperability) الذي يُتيح فهم المعلومة وتحليلها وتفسيرها، لا مجرّد تناقلها. |
|
ومن أبرز الأمثلة المحلية مشروع القاموس الدوائيّ الذي يوحّد الترميزات والمصطلحات بين المستشفيات وهيئة الدواء والغذاء ونوبكو ومجلس الضمان الصحيّ برقمٍ دوائيّ موحّد. |
|
أشارت الدراسة بأن إهمال تبنّي الأنظمة البينيّة والبقاء على النموذج الهيكليّ التقليديّ يؤدّي إلى أوامر مكرّرة ومتفرّقة وغير متاحة في اللحظات الحرجة عند اتخاذ القرار الطبيّ الذي يُفترض منه خدمة المريض أوّلًا. |
|
لكن حتى لو توفّرت الأنظمة البينيّة، ما الذي يضمن أنها تعمل بانسجامٍ وتخضع لمساءلةٍ واضحة؟ |
لماذا الحوكمة أهمّ من التقنية نفسها؟ |
|
في تقرير منظّمة التعاون الاقتصاديّ والتنمية (OECD) لعام 2022 حول حوكمة البيانات الصحيّة، أُشير فيه وبشكل واضح بأن نجاح الأنظمة البينيّة يعتمد أساسًا على قوة الحوكمة التقنية كشرطٍ أوليّ واستباقيّ. |
|
لذا لكي تنجح فكرة الحوكمة في الأنظمة التشغيلية البينية ينبغي الإجابة على أسئلةٍ أساسية مثل: |
|
|
فمن دون إجاباتٍ واضحة، تتحوّل التقنية إلى فوضى رقمية بين الجهات المشاركة، وذلك لأن التقنية دون حوكمةٍ ضابطة لا تصنع شفافية، بل تُعمِّق التشتّت بين مختلف الأطراف. |
ما أبرز المخاطر المتوقعة عند تبنّي الأنظمة البينيّة؟ |
|
في وثيقة ECRI لعام 2024 م وهي منظمة أمريكية غير ربحية متخصّصة في تقييم المخاطر التقنية في القطاع الصحيّ، حذّرت من أبرز المخاطر التقنية المتوقّعة، وشجّعت على تبنّي الحوكمة الصارمة للحدّ من الأخطاء التشغيلية والأمنية. |
|
من أبرز هذه المخاطر: |
|
هل الحل النهائيّ في الأنظمة البينيّة؟ |
|
بعد استعراض ما سبق ينبغي علينا ألا ننظر إلى الموضوع بنظرةٍ حالمة، لأن وجود أنظمةٍ تكاملية وتشاركية لن ينجح ما لم تتغيّر العقلية الإدارية التقليدية. |
|
فالأنظمة البينيّة لا تستطيع وحدها كسر حاجز الخوف من مشاركة البيانات، لأن ذلك يتطلّب ثقافة شفافيةٍ ومساءلةٍ مستمرة. |
|
وعندما يقرّر صانع القرار تبنّي مثل هذا النظام، عليه أن يضع في حسبانه حجم الصرف الماليّ الكبير، والحوكمة التنظيمية الضابطة، وتدريب آلاف الموظفين وتشجيعهم على الاستخدام الفعّال، لأنها عملية معقّدة تمتدّ لعقودٍ متواصلة. |
|
فمن دون مساءلةٍ وتصحيحٍ مستمرَّيْن، ومع ضعف القرارات الإدارية، تتقوّض جهود الدولة في تبنّي التقنية وخدمة المريض. |
لماذا تطرقنا لفكرة الأنظمة البينية من الأساس؟ |
|
إنّ جوهر المشكلة في بيئات العمل الصحيّة ليس في النظام الإلكتروني بحد ذاته، بل في الفلسفة التي يقوم عليها القرار. |
|
فالنظام الهرمي بطبيعته يضع القرار في الأعلى، والمعرفة في الأسفل، ثم يتوقّع أن تسير العجلة بانسجام تام، لكن الحقيقة أن هذا النمط لا ينتج انسجامًا بل بطئا تتم ملاحظته جليا. |
|
وهنا تبرز قيمة التشغيل البيني، لا بوصفه “نظامًا تقنيًا” بل كعقلية مؤسسية جديدة تعيد تعريف العلاقة بين المعلومة والقرار، فالتشغيل البيني يجعل المعلومة هي مركز القوة والثقل في النظام الصحي ويجعل القرار مبنيًا على الحقيقة، لا على التسلسل الهرمي، فهو مثال حي في الانتقال من مفهوم “الأوامر من الأعلى” إلى منطق “بيانات من كل اتجاه”. |
|
فهل يمكننا في يومٍ ما أن نرى نظامنا الصحيّ لا يُدار من قمة الهرم، بل من قلب المعلومة نفسها؟ |
|
وأيهما سيكون أقرب إلى شفاء المريض القرار الذي يُتخذ في الأعلى، أم المعرفة التي تنبض في الميدان؟ |
ما هي الخلاصـــــــــــــــــــــــــــــــــة؟ |
|
حين يُبنى القرار على الهيكل الهرمي لا على المعرفة، تتحوّل التقنية من أداة تقدم إلى سبب شلل. في هذه النشرة تطرقنا لمشهد واقعي في مستشفى مرجعي توقّف عن العمل ساعاتٍ طويلة يوم أطلق نظامه الإلكتروني الجديد، لأن القرار اتُّخذ من القمة دون أن يُسمع صوت من يعمل في الميدان. مثل هذه الحادثة لم تكن في الأصل خللًا في البرمجة، بل في الفلسفة الإدارية نفسها. |
|
من هنا تبرز قيمة «التشغيل البيني» كبديل واعٍ للنظم الهرمية، إذ يُعيد توزيع القوة من المنصب حتى وصول المعلومة المعلومة. ففي النظام البيني تتكامل الأنظمة وتُفتح قنوات تبادل البيانات في الوقت الفعلي، كما هو الحال في مشاريع وطنية مثل «نفيس» و«القاموس الدوائي» التي جعلت المريض محور القرار، لا ضحيته. |
|
حيث جوهر الرسالة بأن شفاء المريض يبدأ من النظام الذي يُدير المعلومة بعدالة، لا من الدواء الذي يُعطى في آخر الرحلة، فهل آن الأوان أن نعيد التفكير في إدارة نظامنا الصحي من قلب المعلومة لا من قمّة الهرم؟ |
| *** |
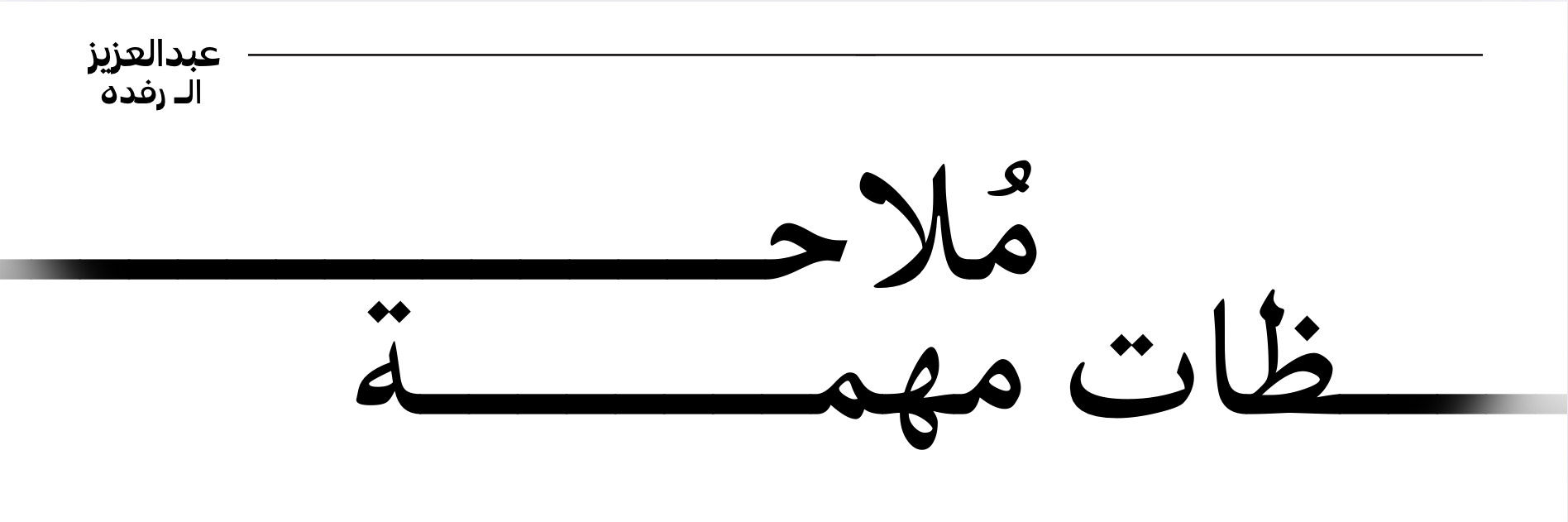
|
|
ممتن لوصولك لهذا السطر من النشرة والتي أتمنى أنها عادت إليك بالنفع، ففيها أنقل للقارئ تجربتي في دراسة الماجستير التنفيذي في التشريعات الدوائية بجامعة الملك سعود منذ العام 2023 م ( Executive Master of Drug Regulatory Affairs in KSU) بشكل نصف أسبوعي في صباح يوم الإثنين ☀️ بالإضافة لنقل الخبرات والمقالات والمقابلات التي قد أعمل عليها خلال هذه الرحلة، وهي لا تُعبرّ إلا عن وجهة نظر ناقلها، راغبا بذلك توثيق الرحلة مع الآخرين ومشاركتهم طريق التعلم في أحد أعرق جامعات المملكة العربية السعودية. |
|
ناقل هذه التجربة هو أنا عبدالعزيز آل رفده تجدني في منصة linkedin،أو منصة Twitter (X) صيدلي بمدينة الملك سعود الطبية وكاتب ابداعي لعديد من المقالات والنشرات البريدية منذ العام 2018م وحتى هذا اليوم. |
|
إن كنت مهتما عن السبب وراء رغبتي في توثيق ونقل هذه التجربة فأود إخبارك بأني قد أفردت لها نشرة سابقة من أعداد التشريعات في أسبوع البريدية والتي كانت بعنوان ( ما هو السبب الذي يجعلني أكتب نشرة التشريعات في أسبوع البريدية؟) وفي نشرة أخرى كذلك كتبت عددا لاقى رواجا كبيرا بين القراء بعنوان (لماذا أنصحك بدراسة الماجستير التنفيذي في التشريعات الدوائية، واستكمال رحلتك المهنية عن طريقها؟). |
|
لإيماني بإثراء المحتوى العربي بشكل عام والصيدلاني بشخص خاص بدأت هذه الرحلة، وقد وصلتني عن نشرة التشريعات في أسبوع الكثير من كلمات المديح والتشجيع سواء من أعضاء هيئة التدريس، أو زملاء الدفعة الدراسية، أو ممن ينتسبون في السلك الصيدلاني بكافة قطاعاته، سعيد بأن سلسلة النشرات البريدية قد نالت استحسانهم، وبإذن الله بأن القادم منها أجمل بهاءْ وحُلّة. 🙏🏼 |
| *** |
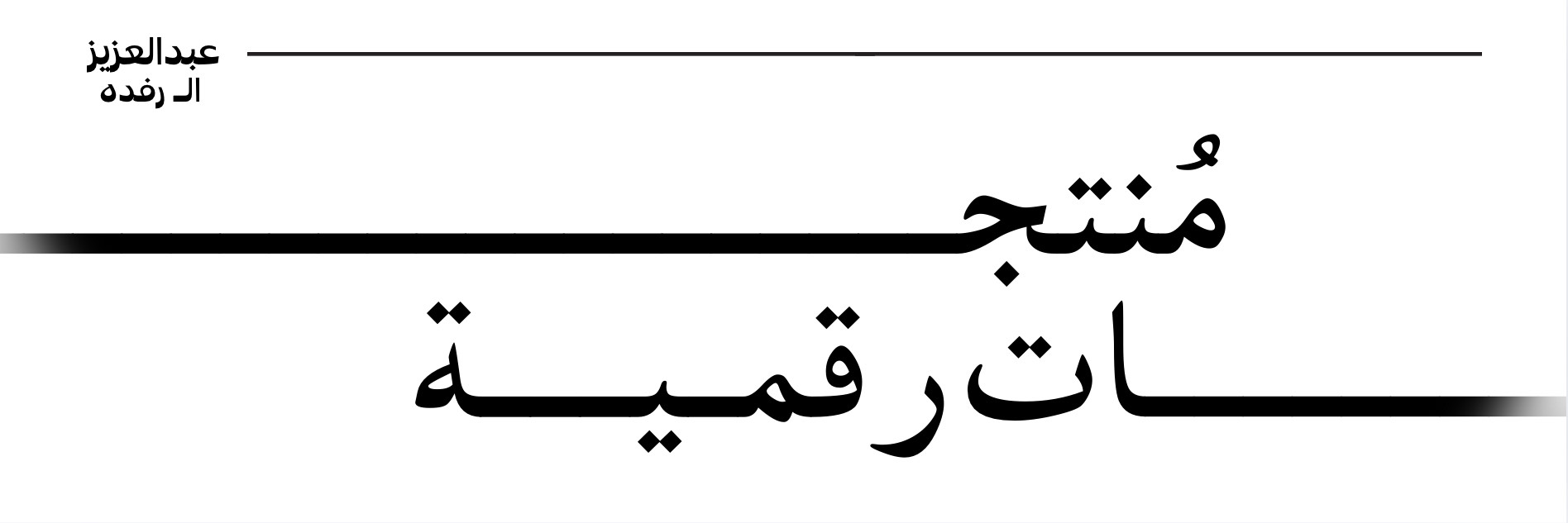
|
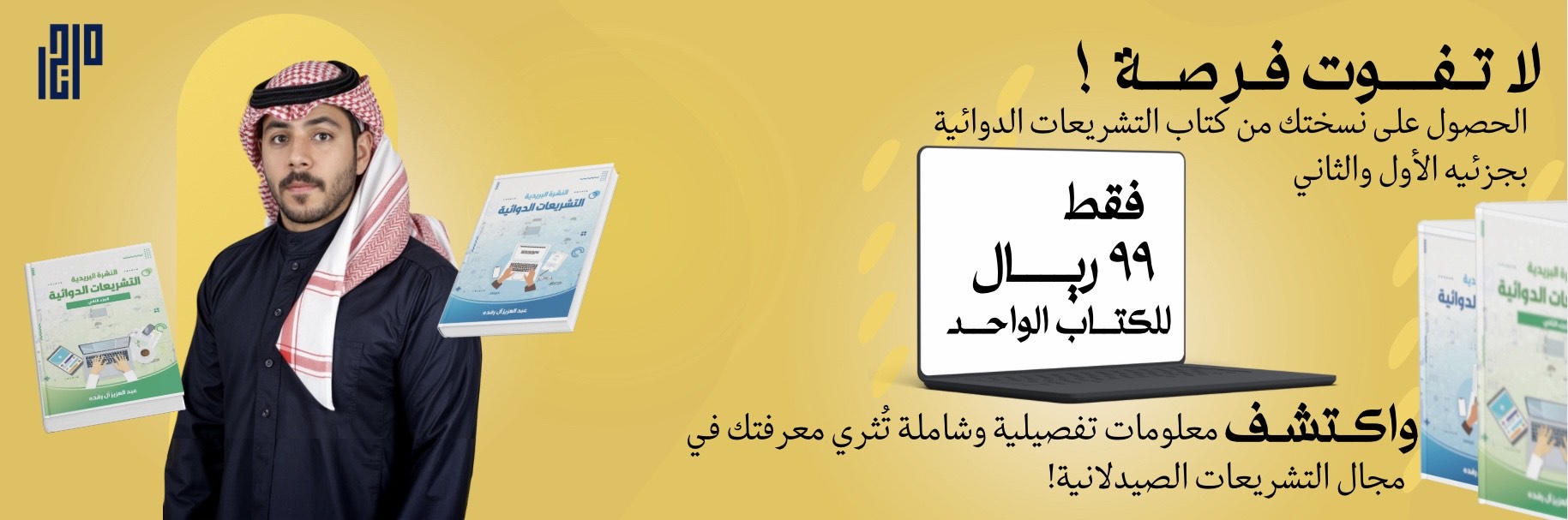
|
استعد لرحلة مثيرة مع هذين الكتابين اللذين سيغيّران نظرتك حول عالم التشريعات الدوائية |
| احصل على نسختك الإلكترونية من كتابّي التشريعات الدوائية عبر الرابط الآن |
| *** |

|
| *** |
نشرات مرجعية مهمة من أرشيف نشرة التشريعات في أسبوع البريدية 📌 |
|
| *** |
|
إن كان هناك أسئلة تتعلق بكل ما ورد أعلاه أو اقتراحات للتطوير من النشرة بإضافة أفكار لها لا تتردد في مراسلتي عبر البريد الإلكتروني للنشرة من خلال هذا العنوان [email protected] |
نشرة التشريعات في أسبوع البريدية
هنا أنقل لك تجربتي في دراسة الماجستير التنفيذي في التشريعات الدوائية بجامعة الملك سعود 2023 م، وهي لا تعبر إلا عن وجهة نظر ناقلها، أرغب فيها بتوثيق الرحلة مع الآخرين ومشاركتهم طريق التعلم في أحد أعرق جامعات المملكة العربية السعودية، اشترك الآن لمتابعة الأعداد فور صدورها صباح كل يوم اثنين 📤
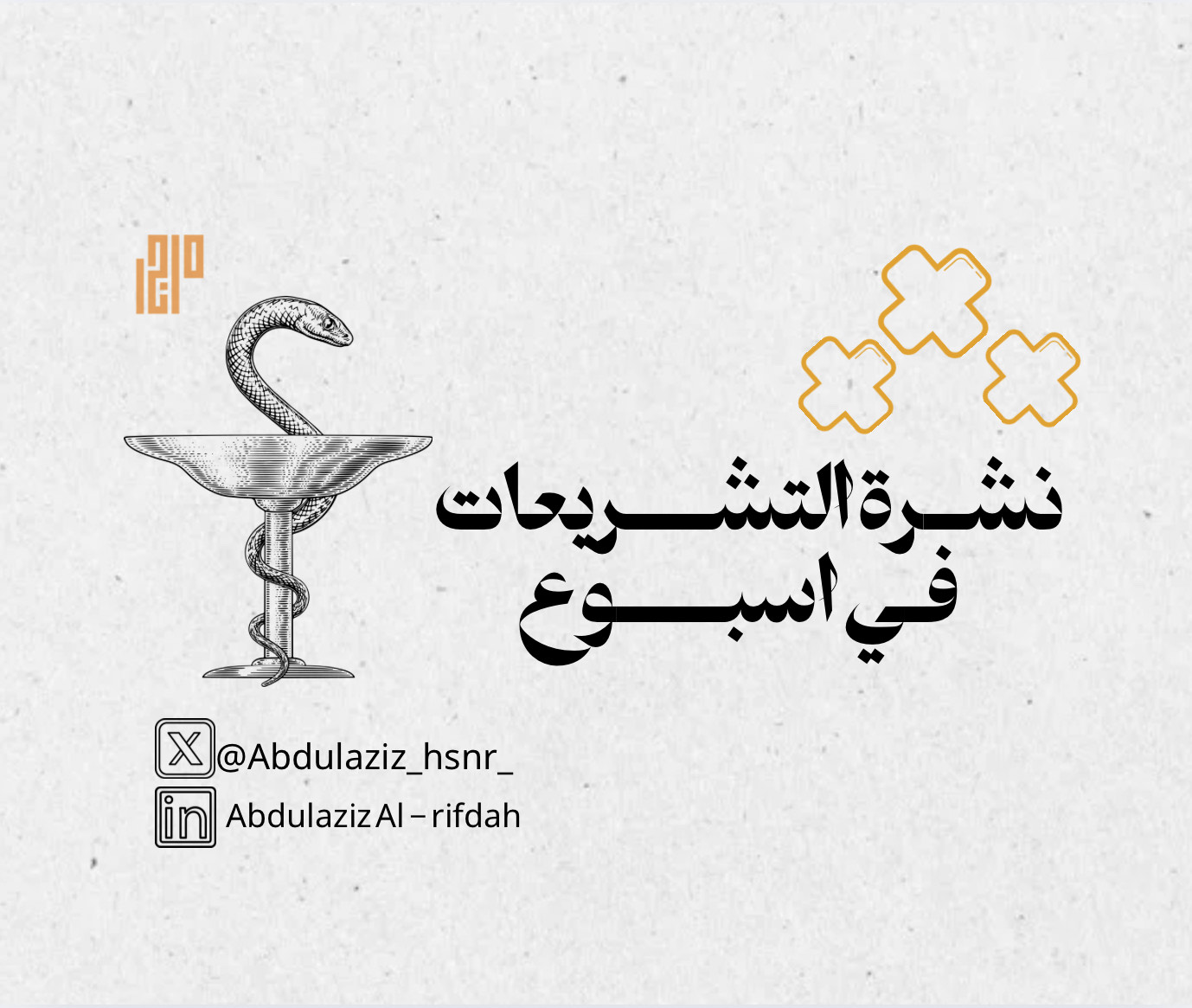
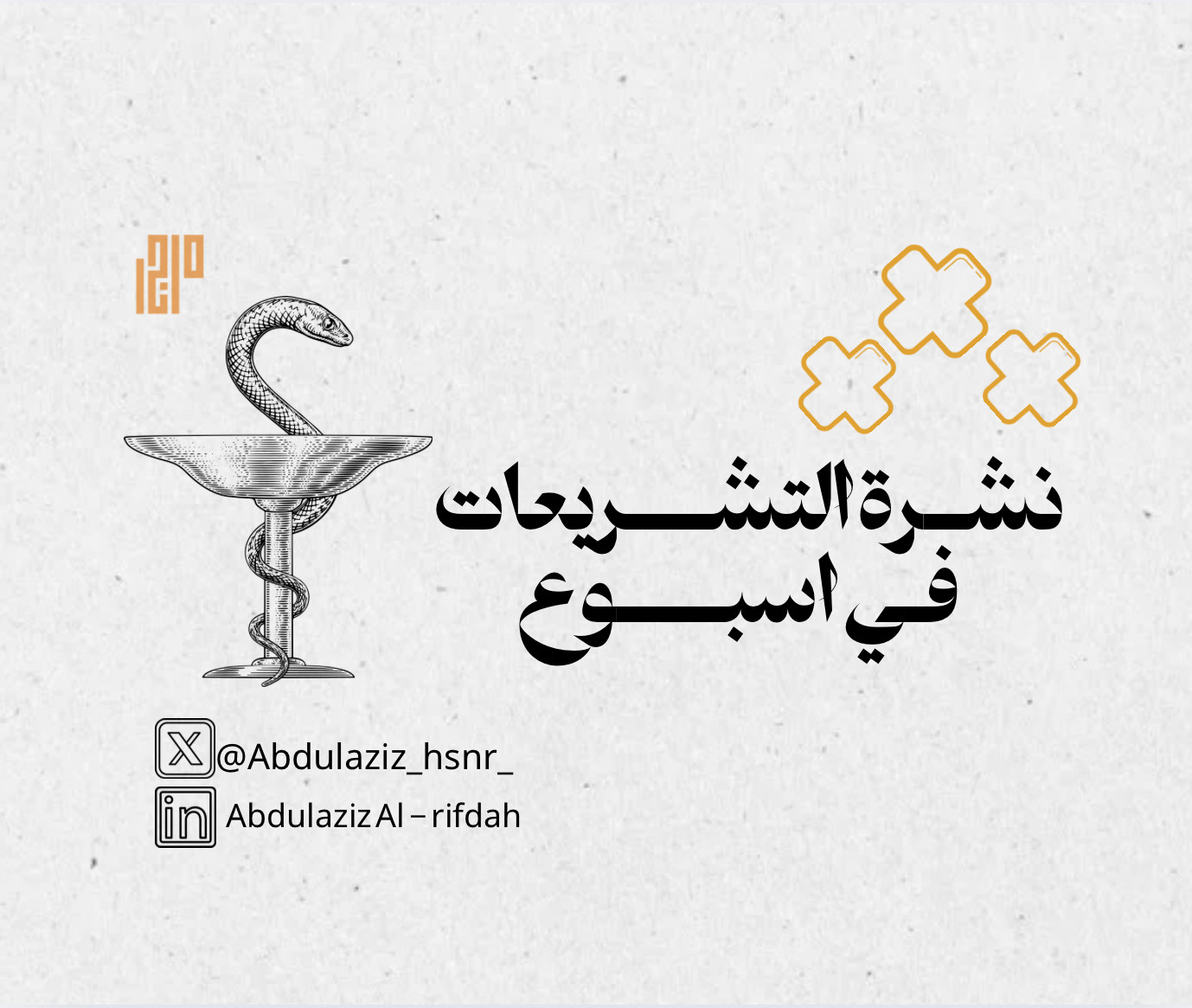
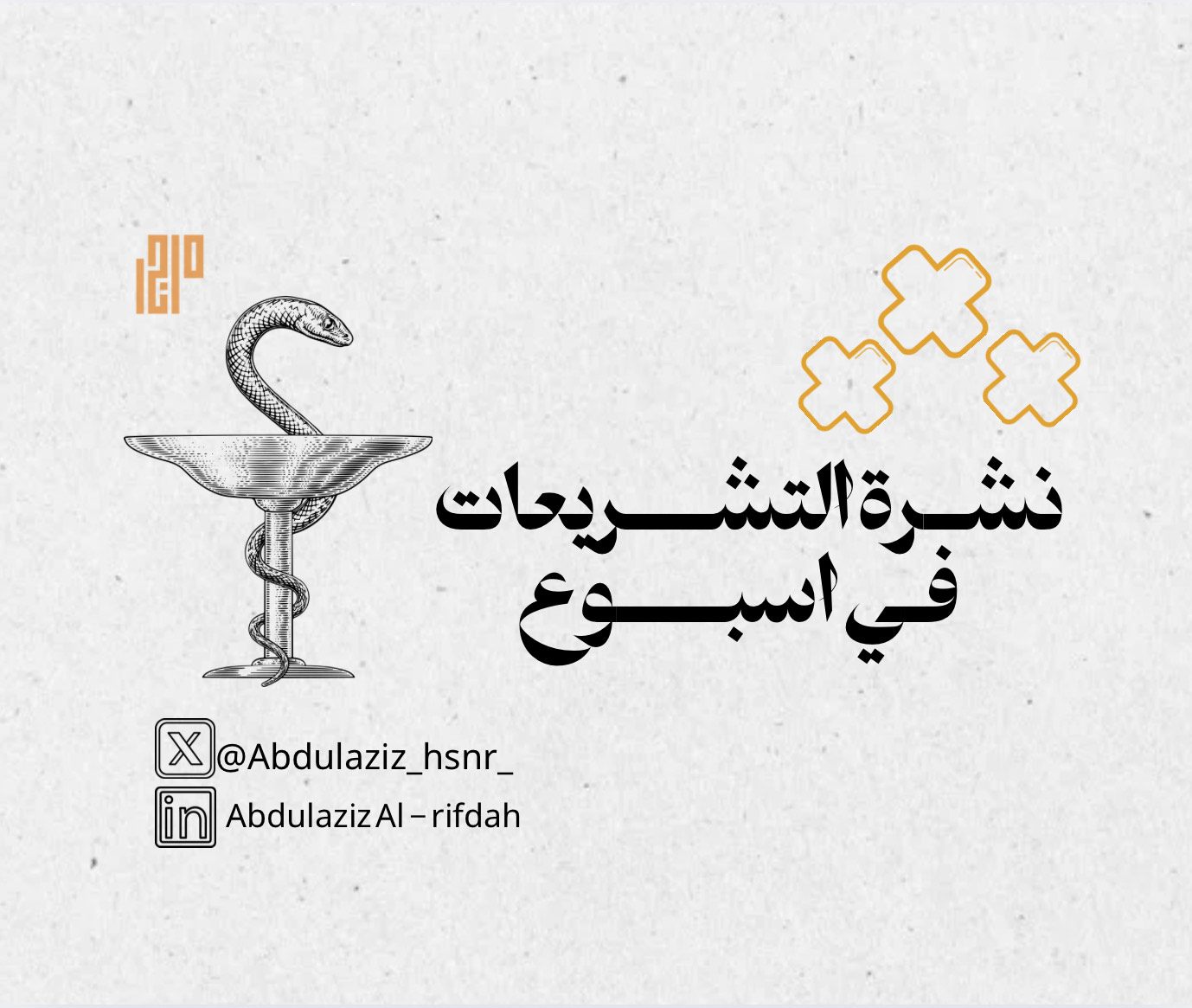
التعليقات