معركة التوفيق |
| 24 فبراير 2025 • بواسطة توّاق • #العدد 2 • عرض في المتصفح |
|
بين طلب العلم و العمل المهني
|
|
|
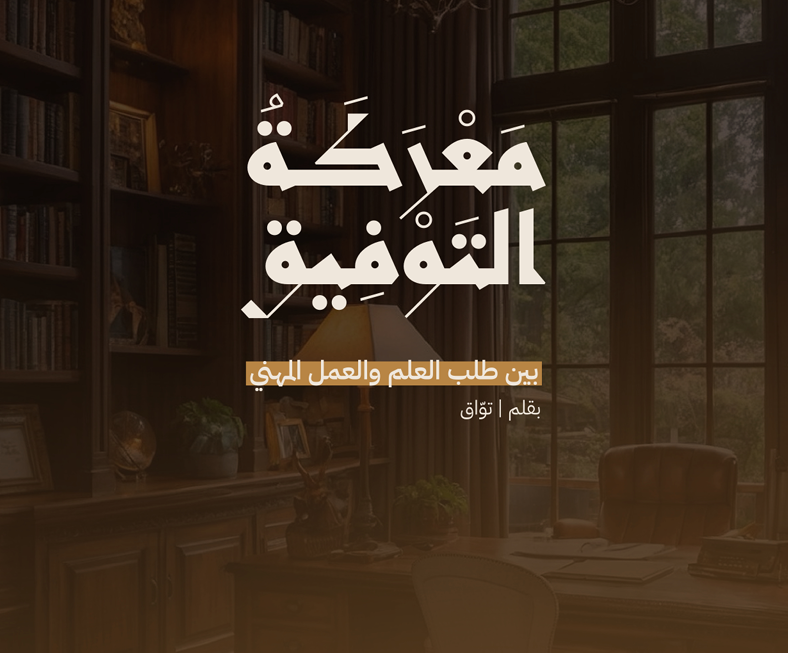
|
|
كانت ليلةً طويلة، من تلك الليالي الشتائية التي ينساب فيها الوقت ببطء، وتستدرجك فيها الأفكار إلى مجاهل التأمل، حيث يهدأ ضجيج العالم، وتبقى وحدك في مواجهة الأسئلة المؤجلة، جلست في زاوية المكتبة، المصباح الزيتي يلقي بريقه الشاحب على أكوام الكتب، وأوراقٌ متناثرة تحكي عن معارك لم تكتمل، وأماني تمتدّ أبعد من الأجل. |
|
وفي غمرة هذا الشرود، امتدت يدي بلا قصد إلى رفّ قريب، فوقعت على كتابٍ قديم، فتحت صفحاته، فإذا بي أمام كلماتٍ تشبه صوتًا داخليًا كنت أبحث عنه منذ زمن: "فأسعد الناس من له قوت دار بقدر الكفاية، لا من منن الناس وصدقاتهم، وقد قنع به، فإنه حينئذ يجتمع همه لمطلوباته من الدين والدنيا والعلم، وأما إذا لم يكن له قوت يكفي، فالهم الذي يريد اجتماعه في تلك الأمور يتشتت."[1] |
|
توقفت طويلًا عند هذه الكلمات، شعرت كأنها تلقي الضوء على زاويةٍ معتمةٍ في تفكير معاصر. لطالما سمعت أن السعي الحثيث والركض المتواصل هو السبيل للخلاص من قلق المستقبل، لكن ابن الجوزي كان يضع يده على معادلةٍ أعمق: أن تكون لك كفايتك، دون أن يأسرك طلب المزيد، فتُمنح نعمة الاجتماع، اجتماع القلب والفكر على ما هو أنفع وأبقى، أغلقت الكتاب وتأملت من جديد، كيف صار الناس أسرى لهذه العجلة، يكدّون من الفجر إلى الفجر، يلتهمهم القلق قبل أن يلتهموا أرزاقهم، يتراكم لديهم المال وتتراكم معه الهموم. |
|
ثم إذا تأملت في رحاب الأزمنة المتراكضة، ستجد أن طالب العلم يقف على مفترق طرق، حيث تَشدُّه رُوح النصوص إلى معارج الفكر والتدبر، فيما تُلزمه أعباء الحياة بمقتضيات الكسب والسعي، وما بين ندائية الوحي وضرورات المعاش، تتماوج الأسئلة في خاطره: هل إلى الجمع من سبيل؟ أم أن دروب الفقهاء الأوائل باتت عسيرة في ظل تعقيد الأزمنة؟ |
|
إذ يجد المرء نفسه ممزقًا بين واجب الاكتساب وسُموّ التفقه، وهذا الإشكال في جوهره، ليس وليد اللحظة، بل هو عودٌ على بدء، امتُحن به العلماء عبر العصور، فها هو أبو يوسف، تلميذ أبي حنيفة، يوازن بين القضاء والعلم، وها هو الليث بن سعد، يُسيّر تجارته ولا يُقصّر في درسه، بل إن ابن المبارك يجمع بين ميادين الجهاد والتجارة ومجالس الحديث، دون أن يختل له ميزان. |
|
لكن العائق في زماننا ليس في ذات التوفيق بين العلم والعمل، وإنما في تلك الفوضوية التي تسربلت بها الأوقات، وفي خلوّ العزائم من الانضباط، فمتى ضاعت المنهجية، تفرّق الجهد في الشعاب، وصار الساعي بين العلم والعمل لا يبلغ من أحدهما نصيبًا موفورًا. |
|
والحق أن هذه الإشكالية لا تأتي من باب تضادٍّ بين العلم والعمل، إذ كلاهما مطلوب شرعًا، وإنما تنشأ من ضعف التوازن بينهما، فإما أن يغلب أحدهما فيطغى على الآخر، أو أن يتأرجح السائر بينهما حتى ينهكه التعب دون ثمرة تُرجى، وكثيرٌ من طلاب العلم اليوم يقعون بين أمرين: إما التفرغ الكامل للطلب مع ضيق ذات اليد، أو الانشغال بالكسب حتى يذبل الطلب ويتلاشى، فكيف السبيل إلى الجمع بينهما؟ |
|
الذي أتصوره من أهم المُعينات على ذلك وضوح المنهجية، فإن طالب العلم الذي يمضي بلا خطة يقع فريسة العشوائية، فيضيع وقته بين المراجع دون فائدة، أو تستهلكه الأعمال اليومية فلا يبقى له متسع للتعلم، و الخطوة الأولى أن يُعيد تمركز فكرة العلم في حياته، وأن يقارب في تصميم نظام محدد يوازن فيه بين طلبه لكفاف عيشه وانشغاله بالتحصيل، فإن الأوقات المهملة تذهب بلا نفع، بينما الدقائق المنتظمة تصنع الفرق ولو بعد حين. |
|
وثمة أصلٌ عظيم يغفل عنه كثير من الناس، وهو البركة في الوقت، فمن صدقت نيته، واستعان بربه، وقرن طلبه بالعمل النافع، بورك له في عمره، وأُوتي من الفهم ما لا يُؤتى صاحب الأوقات الممدودة، وأمثلة ذلك في سلف الأمة أكثر من أن تحصى. |
|
وهذه بعض المسالك تهدي الموفق إلى بر التوازن: |
|
1. تصحيح التصورات التراثية |
|
حين يتحدث بعض الناس عن طلب العلم، يُخيَّل إليهم أنه رحلة زاهدة، يُعرِض فيها طالب العلم عن الدنيا إعراضًا تامًا، فلا يُعنى بكسبٍ ولا تجارةٍ ولا صناعةٍ، كأنما العلم حالةٌ قائمةٌ بذاتها، لا تتأثر بضرورات العيش ومتطلبات الحياة، لكن الحقيقة التي تثبتها النصوص والوقائع أن العلم عبر التاريخ لم يكن منفصلًا عن حركة الاقتصاد، ولم يكن الفقهاء متفرغين تفرغًا رهبانيًا، بل كانوا جزءًا من النشاط البشري، يتكسبون ويطلبون العلم في آنٍ واحد. |
|
وقد وعى العلماء مبكرًا خطورة أن يُطلب العلم على حساب الضرورات، فكانوا يوجّهون طلابهم إلى ترتيب الأولويات، فالخطيب البغدادي يروي في جامعه عن عبدالرحيم بن سليمان الرازي قال: "كنا عند سفيان الثوري، فكان إذا أتاه الرجل يطلب العلم، سأله: هل لك وجه معيشة؟ فإن أخبره أنه في كفاية، أمره بطلب العلم، وإن لم يكن في كفاية، أمره بطلب المعيشة[2]". وهنا تلمس ميزان العلماء الدقيق: فالعلم شريفٌ، لكن الاستغناء عن الناس أشرف، وطلب العلم لا يكون مثمرًا إلا إذا استقام معه معاش الإنسان. |
|
خذ مثلًا الإمام أبا حنيفة، كان تاجرًا في الأقمشة، يدير تجارته، ومع ذلك لم يصرفه ذلك عن طلب العلم وتعليمه، وفي دراسةٍ دقيقة، جاء بها الدكتور محمد التميم باستقراء واسعٍ في رسالته العلمية "مهن الفقهاء في صدر الإسلام"، كشف فيها عن عددٍ كبيرٍ من العلماء الذين كانت لهم مهنهم وأعمالهم إلى جانب اشتغالهم بالعلم، بل إن كثيرًا منهم نُسب إلى مهنته، فأصبح اللقب الذي يعرف به مرتبطًا بصنعته، فكان منهم البزّاز (بائع الأقمشة)، والخياط، والعطار، وغيرهم. |
|
ثم إن المادة العلمية نفسها تحتاج إلى مال، فالكتب تُشترى، والأسفار في سبيل العلم تحتاج إلى نفقات، بل حتى الجلوس بين يدي العلماء كان يتطلب أحيانًا نفقة يتحملها الطالب، فالمال ليس مجرد وسيلةٍ لكسب العيش، بل أداةٌ يستعين بها العالم والمتعلم على أداء رسالته، ومن لم يدرك هذه الحقيقة، بقي أسيرًا لنظرةٍ حالمةٍ تعزل العلم عن الواقع، وهو في جوهره لا ينفك عنه. |
|
2. أولويات الخير |
|
إدراك أن العلم الشرعي ليس كله في مرتبة واحدة، فمنه ما هو فرض عين لا يُعذر العبد بجهله، ومنه ما هو فرض كفاية ينهض له من وُهِب السعة في وقته، فلابد من ترتيب الأولويات وفق الحاجة الشخصية ومتطلبات البيئة المجتمعية، ومن لم يُحسن ترتيب أولوياته، فسيرفع صوته بشكوى مسغبة الأوقات، فليس كل علمٍ يُطلب دفعة واحدة، ولا كل مسألةٍ تستوجب الانكباب التام، بل إن من أدرك أن طلب العلم مسيرة ممتدة، لا غزوة خاطفة، هانت عليه مشقة التدرج، فلتكن البداية بالمتون الأساسية، والقواعد الأصولية، والعلوم التي لا يسع المسلم جهلها، ثم يتوسع بعد ذلك بقدر طاقته. ولم تزل كلمات الماوردي شاهدة على هذه الحقيقة حينما قال: " واعلم أن للعلوم أوائل تؤدي إلى أواخرها، ومداخل تفضي إلى حقائقها، فليبتدئ طالب العلم بأوائلها لينتهي إلى أواخرها، وبمداخلها لتفضي إلى حقائقها، ولا يطلب الآخر قبل الأول[3]." فمن وعى هذه الوصية الماوردية، علم أن الجمع بين العمل والعلم ليس مفاضلة بين خير وشر، بل هو ترتيب بين أولويات الخير، وأن الحكمة كل الحكمة في أن يضع الإنسان وقته حيث يكون أثره أعظم، وعلمه حيث يكون نفعه أعمّ. |
|
3. إحكام إدارة الوقت |
|
فالزمن في أصله رأس مال طالب العلم، وهو متاح للجميع بقدر واحد، لكن التفاوت يكمن في استثماره، وقد صدق ابن عقيل الحنبلي حين قال: “إني لا يحل لي أن أضيع ساعة من عمري، حتى إذا تعطل لساني عن مذاكرة ومناظرة، وبصري عن مطالعة، أعملت فكري في حال راحتي وأنا مستلقي.[4]” فإنَّ الزمانَ مطايا السائرين، ومن أتقنَ اقتناص الفرص بين أشغال المهنة، واستغلّ فُسح الأوقات في القراءة والمذاكرة، أدرك ما يعجز عنه كثيرٌ من المتفرغين الذين تتسربُ أعمارهم في اللهو المُقنّع والتسويف المُمَنهج. |
|
4. العلم المرقمن |
|
إذ لم تعد وسائل التحصيل مقتصرة على حضور الدروس، فالتسجيلات والمحاضرات والكتب الرقمية، كلها وسائل تقرّب البعيد، وتيسّر الجمع بين طلب العلم ومقتضيات العمل، ولقد يسّرت التقنية اليوم ما لم يكن متاحًا في القرون الماضية، فالدروس باتت مسجلة، والكتب متاحة رقميًا، والبحوث العلمية في متناول اليد بضغطة زر، فمن لم يجد وقتًا للجلوس بين يدي الشيخ، يمكنه الاستماع أثناء طريق العمل، ومن لم يتمكن من اقتناء المراجع، فالمكتبات الرقمية أصبحت تغني عن ذلك، فالذكي من يجعل التقنية خادمة له في التحصيل، لا أن يكون عبدًا لها في الترفيه والاستهلاك. |
|
5. نزيف الأعمار |
|
فقد أصبح عصرنا يموج بالمشتتات التي تسحب الأوقات دون أن يشعر المرء، ولو أجرى محاسبة دقيقة، لوجد أن كثيرًا من أوقاته تذهب في غير طائل، ولو استُثمرت في مدارج العلم لبلغ بها شأنًا عظيمًا، ومن يترك نفسه لتيارات الوقت والأعمال، فلن يحصد سوى التراكم العشوائي، أما من نظم يومه، فخصّص للأصول وقتًا ثابتًا، وجعل للتحصيل وقتًا مقدرًا، فقد أرسى سفينته على شاطئ النجاة، فلو أن كل طالب علم خصّص من يومه ساعةً أو ساعتين، ثابتة لا تُمسّ، يملؤها بالحفظ والمراجعة، لاستطاع أن يبني صرحًا علميًا متينًا ولو بعد حين، ومن الحقائق يا صاحبي أنه لا يُستطاع الجمع بين طلب العلم والعمل المهني إلا بقطع ما لا طائل منه من الملهيات، التي تسرق العمر دون أثر، فالتخفف من الاستغراق في وسائل التواصل الاجتماعي، وتقليل الأوقات المهدرة في الجلسات التي لا تزيد المرء إلا تثاقلاً، واستثمار الأوقات البينية—كأوقات الانتظار والتنقل—في المراجعة والاستماع، كل ذلك يساهم في تحقيق التوازن المنشود، وهذا ابن الجوزي يصدح بهذا الصوت فيقول " ولقد شاهدت خلقا كثيراً لا يعرفون معنى الحياة، فمنهم من أغناه الله عن التكسب بكثرة ماله، فهو يقعد في السوق أكثر النهار ينظر إلى الناس، وكم تمر به من آفة ومنكر، ومنهم من يخلو بلعب الشطرنج، ومنهم من يقطع الزمان بحكاية الحوادث عن السلاطين والغلاء والرخص إلى غير ذلك، فعلمت أن الله تعالى لم يطلع هؤلاء على شرف العمر ومعرفة قدر أوقات العافية إلا من وفقه وألهمه اغتنام ذلك، (وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم) (١). نسأل الله أن يعرفنا شرف أوقات العمر، وأن يوفقنا لاغتنامه."[5] |
|
6. إحياء الابتغاء الأخروي |
|
فمنهج الله في الحياة لا يُقصي الدنيا لصالح الآخرة، ولا يجعل الدنيا مستقر القلب ونهاية السعي، بل هو ميزان دقيق، تتّجه فيه الجوارح إلى العمل، والقلب إلى الآخرة، ثم تأمل في قوله تعالى: "وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا[6]"، تجد أن الخطاب لا يدعو إلى هجر الدنيا، بل يربطها بالمقصد الأعلى، بحيث يكون السعي في الأرض جزءًا من عبادة الله، لا انحرافًا عن سبيله، وحين يدرك الإنسان أن المتاع ليس مجرد لذةٍ، بل لونٌ من ألوان الشكر، يصبح أخذه له عبادة، وتقبّله له قربة، فترتقي روحه كلما تحرك في دنياه، بلا حرمانٍ يُضعفها، ولا إسرافٍ يُفسدها، وهكذا يتحقق الاتزان في مسيرة العبد، فلا يذوب في متاع الدنيا، ولا يغفل عن زاده إلى الآخرة، بل يجعل دنياه معبرًا إلى نعيمٍ لا ينفد، ومن الأهمية بمكان أن يُضبط مفهوم الكسب لدى المرء، هناك منازل بين أن تلبي احتياج لتعيش وبين أن تتخيل مساهماتك في البورصة العالمية، ومن وفقه الله لجمع المال، فجعل نصيبًا منه للعلم، دعمًا لطلبته ومؤسساته، فتحققت به بركة المال والعلم معًا. |
|
7- التآخي في الطلب |
|
فإنَّ الجمعَ بين العلمِ والعملِ ضربٌ من مجاهدةِ النفس، لا يقومُ إلا على عزمٍ متوقدٍ، والعزائمُ لا تُشحَذُ إلا بالمنافسةِ الصالحة، إذِ القلوبُ بطبعِها تضعُفُ حين تنفرد، وتشتدُّ حين تلتئم، فإذا كان للمرءِ رفقةٌ صالحةٌ، تشدُّه إلى مجالسِ العلمِ وتذكِّره بمقاصدِه، خفَّت عليه وعورةُ الطريق، فإنَّ المرءَ وحدَه هشٌّ، تتخطفُه الرياحُ، قويٌّ بإخوانِه، يأخذُ بيدِهم ويأخذون بيده، يدفعون عنه غوائلَ الفتور، وينبهونه إذا غفلَ في زحمةِ الشواغل، ويوصي الشيخ بكر أبو زيد الطالب فيقول له "تخير للزمالة والصداقة من يعينك على مطلبك، ويقربك إلى ربك ويوافقك على شريف غرضك ومقصدك[7]" |
|
ولقد كان العلماء أدرى بطبيعة النفس، وأعلم بما تعتريها من الفتور والتواني، فلم يتركوا سبيلًا يعين على الثبات إلا ودلّوا عليه، وكان من أجلِّها التآخي في طلب العلم، والتواصي بالحق في رياضه، وتلقيه في حلقٍ عامرة، والانضواءِ تحت رايةِ العلماء، فإنَّ العلمَ حين يكونُ وحدانيًا، يكون يابسًا عسيرَ المأخذ، فإذا أُخذ في جماعةٍ، انبسطت معانيه، وتفتَّحت خزائنُه، فكان أيسرَ في التحصيل، وألذَّ في المدارسة، واليومَ وإن تقطَّعت بعضُ السبلِ، فقد انفسحت أبوابٌ أخرى، فصحبةُ الصالحين تُلتمسُ في حلقاتِ المساجدِ كما كانت، أو في البرامج العلميةِ المنتظمة، عبر المنصاتِ التي ضمَّت المتفرِّقَ، وجمعتِ المشتَّت، فأصبحَ التواصي والتذاكر والتدارسُ ميسورًا لمن جدَّ في طلبِه، وأحسنَ البحثَ عن أهله. |
|
8- أودية العلم |
|
كثيرٌ من طلاب العلم ينظرون إلى مشاغلهم اليومية، فيتحسرون على قلة الوقت المتاح، فيظنون أن ما لديهم من وقت لا يكفي للإنجاز، فيُعرضون بالكلية، ولو أن طالب العلم التزم يوميًا بساعة واحدة فقط، يحفظ فيها، أو يراجع، أو يستمع إلى درس، لجمع في سنة ما لا يجمعه كثيرٌ ممن يندفعون شهرًا ثم ينقطعون عامًا، فالقليل المستمر خيرٌ من الكثير المنقطع، وهذا أصلٌ مجرب، ولهذا من أعظم قواعد النجاح قول النبي ﷺ: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قلّ.[8]، و السلف كان ينكرون العلجة في تلقي العلم فهذا الإمام سفيان الثوري سأله شاب عن حديث فأجابه، ثم عن آخر فأجابه، ثم عن ثالث فأجابه، ثم سأله في الرابعة، فقال: إنما كنت أقرأ على الشيوخ الحديثين والثلاثة، لا أزيد حتى أعرف العلم والعمل بها. فألحَّ الشاب عليه فلم يجبه. فجلس الشاب يبكي، فقال له سفيان: يا هذا تريد ما أخذته في أربعين سنة تأخذه أنت في يوم واحد؟"[9] ومناقض عنوان هذا المسلك العجلة في تلقي العلم فهذا يونس بن يزيد قال: قال لي ابن شهاب، يا يونس، «لا تكابر العلم؛ فإن العلم أودية، فأيها أخذت فيه قطع بك قبل أن تبلغه ولكن خذه مع الأيام والليالي، ولا تأخذ العلم جملة؛ فإن من رام أخذه جملة ذهب عنه جملة ولكن الشيء بعد الشيء مع الليالي والأيام» [10] |
|
9- ثمرات المواسم |
|
إن دأب أهل العلم على التماس أوقات الفراغ لتكثيف التحصيل ديدنٌ قديم، فالمواسم العلمية والعبادية كانت فرصة سانحة لأرباب المهن والأعمال الذين يجدون في أيام السنة فترات تهدأ فيها المشاغل، وتنفسح فيها السبل للتحصيل الجاد، فالإجازات السنوية، وشهر رمضان، وموسم الحج، وفترات الركود المهني، كلها محطات ينبغي أن يُحسن استثمارها لتعويض الفجوات العلمية الناشئة عن الانشغال بالمعاش، ومن غفل عن هذه الفرص ترك في رصيده العلمي ثغرات لا تُسد. |
|
ولئن كان استثمار المواسم العلمية أمرًا مشهودًا في حياة العلماء المشهورين، فإن في زوايا التاريخ رجالًا لم تخلدهم دفاتر التراجم الكبرى، لكنهم ضربوا بسهم وافر في هذا الميدان، ومن هؤلاء معاوية بن صالح بن حيدر الحضرمي (ت 173 هـ) جاء في ترجمته، أنه حج مرة واحدة، ومرّ بالمدينة، فلقِيه من لقيه من أهل العراق، وكان معه كثير من الحديث، وقال أبو صالح كاتب الليث: مرّ بنا معاوية بن صالح حاجًا بعد سنة أربع وخمسين، فكتب عنه أهل مصر وأهل المدينة ومكة.[11] |
|
فإن كان لأرباب التجارة مواسم يضاعفون فيها أرباحهم، فلأهل العلم كذلك مواسم يضاعفون فيها رصيدهم العلمي، فمن فاتته أيام النشاط في زحمة المشاغل، فليغتنم فترات الهدوء ليجبر ما نقص، وليلحق بركب السائرين في دروب العلم. |
|
10- المعراج الخفي |
|
من استشعر أن الجمع بين العلم والعمل عبادةٌ يتقرب بها إلى الله، هان عليه الطريق، فحين يدرك طالب العلم أن عمله المهني ليس مجرد وسيلة لكسب الرزق، بل هو باب من أبواب العبادة، يتغير المنظور لديه، فإذا نوى بعمله خدمة أمته، وحماية نفسه من الذل، وتمكين نفسه من طلب العلم، صار عمله عبادة، وسهل عليه الجمع بينه وبين التحصيل، ولذا فإن تجديد النية يجعل المشقة أخف، والعقبات أهون، والنتائج أعظم بركة، وهذا ابن جماعة في تذكرته يوصي بــ "حسن النية في طلب العلم بأن يقصد به وجه الله تعالى والعمل به وإحياء الشريعة، وتنوير قلبه وتحلية باطنه والقرب من الله تعالى يوم القيامة والتعرض لما أعد لأهله من رضوانه وعظيم فضله. قال سفيان الثوري: "ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي". ولا يقصد به الأغراض الدنيوية من تحصيل الرياسة والجاه والمال، ومباهاة الأقران، وتعظيم الناس له، وتصديره في المجالس ونحو ذلك، فيستبدل الأدنى بالذي هو خير." ومن أطباء القلوب ابن أبي جَمْرة -رحمه الله- كان يقول: وددتُّ أنه لو كان من الفقهاء من ليس له شُغلٌ إلا أن يُعلّم الناس مقاصدهم في أعمالهم، ويقعد إلى التدريس في أعمال النيّات ليس إلّا، فإنه ما أُتيَ على كثير من الناس إلا من تضييع النيّات[12]. |
|
11- الاقتداء الراسخ |
|
الإنسان كائن متأثر متفاعل، وقلّ أن يسير في دربٍ إلا وقد سبقه إليه مقتدًى به، يترسم خطاه، ويستلهم تجربته، ويتقوى بمسيرته، ومن تأمل في واقع أهل العلم وجد أن اختيار القدوة لم يكن مجرد محاكاة مشيخية، بل كان مسلكًا منهجيًا يسلكه كل طالب جاد، فإن النفس تضعف، والعوائق تتراكم، ولا شيء يعينها على مواصلة السير مثل النظر إلى من سبقها، ممن لاقى المشاق ذاتها، وأُثقل بالهموم عينها، ومع ذلك لم يثنه ذلك عن بلوغ المعالي. |
|
فصفحات السير تُبرز أولئك الذين جمعوا بين العمل والتحصيل، فدونك تراجم العلماء في الطبقات وعند الذهبي وغيرها، الذين كانت أيديهم في معترك الحياة، وأذهانهم في معترك الفهم، ترى فيهم الحرفي الذي يقرأ في فترات راحته، والتاجر الذي لا ينقطع عن حضور الدروس، والقاضي الذي يطوي الليل مطالعةً وتحريرًا، ومع ذلك بلغت علومهم مبلغًا لم يبلغه المتفرغون. |
|
12- التخصص والتكامل |
|
إن انشغال طالب العلم بسد ثغور المعرفة كافة، والسعي إلى الإحاطة بجميع فنونها، مظنةٌ لتشعب الفكر، وتفرق الجهد، وذهاب البركة، فإنما يُدرَك العلم على التدريج، ويُنال بالتركيز، لا بالاستغراق في كل باب. ولهذا، كان الأولى لطالب العلم أن يُحكِم التخصص في فنٍّ بعينه، يُتقنه ويفقه دقائقه، مع استصحاب الإلمام الضروري بغيره من العلوم، حتى لا يختل الميزان، أو يضعف البناء. |
|
وهذا المنهج لا يقتضي العزلة عن بقية العلوم وأهلها، بل يوجب التكامل مع غيره من المتخصصين، حتى تتضافر الجهود، وتتكامل اللبنات، فيكون النتاج المعرفي أكثر إحكامًا، وأشد رسوخًا، فإن العلم لا يبنيه الفرد بمعزلٍ عن غيره، وإنما يُشيَّد بالتآزر، حيث يسد كل عالمٍ ما تخصص فيه، ويتلاقح الفكر بين أرباب الفنون، فيخرج بذلك علمٌ متماسكٌ، متزن الأطراف، محفوظٌ من الخلل الذي يعتري اجتهادات الأفراد المنعزلين، فمن وعى هذه القاعدة، ووازن بين التخصص الذي يعمق الفهم، والتكامل الذي يجبر النقص، حاز العُلا في سلوك السبيل العلمي، وكان ممن رُزِق بركة العلم وثباته. |
|
13- التحصيل المتأني |
|
من لم يُتح له التفرغ في مقتبل عمره، فلا يقعد عن التحصيل بدعوى الانشغال، بل ليضع يده على أصول المسائل، وليؤسس لنفسه قاعدة علمية راسخة ولو ببطء، فإن مدارك الإنسان تنمو مع الزمن، وأعباء الحياة وإن كانت في ظاهرها شاغلة، إلا أنها قد تثمر نضجًا فكريًا يعين على الفهم والاستيعاب. |
|
وإذا استقر به المقام، وخفت عنه وطأة المشاغل، فليُثقل ميزان تحصيله، وليرفع منسوب تعمقه، حتى إذا وجد فسحةً أوسع، أمكنه أن يقتطع جزءًا من وقته، أو ربما يتفرغ كليًا للعلم، فكم من عالمٍ لم يكتمل بناؤه المعرفي إلا في مراحل متأخرة، وكم من مفكرٍ لم يُصغ نتاجه إلا بعد أن انقضت سنون من التجربة والتأمل. وهنا لمحة جوزية في التصنيف المفيد ومراحل عمر العالم يقول فيها أبو الفرج "وينبغي اغتنام التصنيف في وسط العمر؛ لأن أوائل العمر زمن الطلب، وآخره كلال الحواس، وربما خان الفهم والعقل من قدر عمره؛ وإنما يكون التقدير على العادات الغالبة؛ لأنه لا يعلم الغيب، فيكون زمان الطلب والحفظ والتشاغل إلى الأربعين، ثم يبتدئ بعد الأربعين بالتصانيف والتعليم، هذا إذا كان قد بلغ مع ما يريد من الجمع والحفظ، وأعين على تحصيل المطالب." |
|
14- التحصيل لا التشغيب |
|
كثير من طلاب العلم يضيعون أوقاتهم في التعمق في المسائل الجدلية والخلافات التي لا تعود عليهم بنفع عملي، فينشغلون عن بناء أصولهم العلمية بتتبع الجزئيات والردود، ومن أراد الجمع بين العلم والعمل، فعليه أن يُحسن اختيار أولوياته، ويركز على ما ينفعه في دينه ودنياه، وما يعينه على تحقيق الثبات والاستمرارية. |
|
ويدق ابن جماعة ناقوس الخطر أمام المشتغلين بالعلم في بداياته، محذرًا بقوله:"من الانشغال في الاختلاف بين العلماء أو بين الناس مطلقا في العقليات والسمعيات؛ فإنه يحير الذهن ويدهش العقل، بل يتقن أولا كتابا واحدا في فن واحد، أو كتبا في فنون إن كان يحتمل ذلك على طريقة واحدة يرتضيها له شيخه، فإن كانت طريقة شيخه نقل المذاهب والاختلاف ولم يكن له رأي واحد، قال الغزالي: فليحذر منه فإن ضرره أكثر من النفع به."[13] |
|
15- وقف الساعة الذهبية |
|
لا تُبنى العقول على بقايا الأوقات، ولا تُنال المعارف بمنهجية الهامش، حيث يُترك العلم لما يتيسر بعد انقضاء اليوم، فإذا ضاق الجدول، كان أول ما يُحذف هو لحظات التحصيل، هذه الطريقة تضع العلم في دائرة المؤجَّل، فيظل طالب العلم عالقًا بين الطموح النظري والعجز العملي، لا يقطع في رحلته خطوةً ثابتة، لكن ما إن يعكس المرء المنظور، ويجعل وقت العلم هو المحور الذي تُهندَس حوله بقية الالتزامات، حتى يتغير المشهد، فمن أوقف "ساعة ذهبية" يوميًا للعلم، قبل أن تتنازعه مشاغل اليوم، سيجد أن المعرفة صارت ركنًا راسخًا في يومه، لا عارضًا مؤقتًا يزول مع زحمة المهام، فهذه الساعة هي استثمارٌ في البقاء، هي الفارق بين من يتحرك في طلب العلم بمنهجية التراكم الموثوق، ومن يستنزفه الانتظار حتى تتوفر "الظروف المثالية"، فكما يُهندِس التجار أوقاتهم حول مواسم الربح، ينبغي أن يُهندس طالب العلم وقته حول لحظات البناء الحقيقي، تلك التي لا يتركها نهبًا للفوضى، بل يجعلها مقدسةً لا يُفتَأت عليها، فيبدأ بها يومه، فتكون لها الهيمنة على بقية ساعاته. |
|
16- فخ “الانشغال الوهمي” |
|
كثيرون يظنون أن الامتلاء بالحركة يعني التقدم، فتراهم يسابقون الوقت، متنقلين بين المهام، غارقين في الاجتماعات، مستهلكين في الردود والمتابعات، لكن حين يحاسب أحدهم نفسه عند نهاية اليوم، يجد أن الإنجاز الحقيقي لا يكاد يُرى، هذا ما أسميه حالة الانشغال الوهمي، حين ينصرف الجهد إلى الحركة بدل الإنتاج، وإلى التراكم بدل التقدم. |
|
والحقيقة أن الإنجاز ليس في كثرة الانشغالات، بل في حسن الاختيار، أن يُلتقط من زحام الأعمال ما يحقق الأثر، ويُستبعد ما سواه بلا تردد، فمن أراد الجمع بين العلم والعمل، فلا بد أن يُعيد ضبط إيقاع يومه، أن يُقصي المهام الثانوية التي تستهلكه دون عائد، ويُقلل الضجيج المحيط به، حتى لا تتبدد طاقته في تفاصيل عابرة، وتضيع الأيام في تحصيل لا يبني، وتخطيط لا يتحقق. |
|
ومن رام الموازنة بين العلم والمعاش، فعليه أن يُمسك بالمفاصل الأساسية، أن يكون انتقائيًا فيما يشغل به وقته، متيقظًا لمزالق الانشغال العقيم، حريصًا على أن يكون يومه محسوبًا بميزان الأولويات، حتى لا يكتشف متأخرًا أنه كان يجري بلا وجهة، ويتحرك بلا أثر. |
|
17- قاعدة: توزيعٌ لا تضييع |
|
الذين يرزحون تحت ثقل فكرة "الوقت المثالي لطلب العلم"، يبقون عالقين في دوامة التأجيل، ينتظرون الفراغ التام، والمناخ المثالي، والساعة الطويلة الخالية من المقاطعات، فلا يبدؤون أبدًا، لكن العلم، شأنه شأن الماء الجاري، لا يحتاج إلى خزان ضخم، بل يكفي أن يُجري صاحبه نهرًا صغيرًا لكنه مستمر، وهنا تبرز "التجزئة الذكية"، حيث لا يكون طلب العلم مشروعًا مؤجلًا إلى ساعات الفراغ النادرة، بل يكون حاضراً في تفاصيل اليوم، يتغلغل في ثنايا الوقت، ويُقتنص في لحظات متناثرة، عشر دقائق في الصباح لقراءة مختصرة، ثم درسٌ صوتي يُسمع أثناء العمل، فمراجعة ملاحظات قبل النوم، وهكذا يُصبح التحصيل ممتدًا بلا إرهاق، مستمرًا بلا انقطاع. |
|
هذه الطريقة ليست حيلة لتخفيف المشقة، بل هي سنة عقلائية في تحصيل المعارف الكبرى، والتجربة شاهدة أن العقول التي تستوعب ببطء لكن باستمرار، تُنتج رسوخًا أعمق، وبصيرةً أدق، بعكس من يضغط نفسه في ساعات طويلة ثم ينقطع، فينسى ما جمع، ويفتر ما همَّ به، فمن أراد الاستمرار في طريق العلم، فليستبدل صورة العالم المعزول في خلوته، بصورة طالبٍ يبني نفسه لبنةً بعد لبنة، وفق هندسة الوقت لا وفق مزاج الفراغ. |
|
18- المعايشة اليومية |
|
العلم إن بقي حبيس الكتب لم يُثمر، وإن لم يجرِ على الألسنة لم يترسخ، فهو نورٌ لا يُستنار به إلا إذا سرت أنواره في الأحاديث، وامتدت في المجالس، وتخللت الأحاديث اليومية كما يتخلل الماء أوصال الأرض العطشى، إن من أخطر ما يُصيب طالب العلم أن يحصره في لحظات القراءة المنعزلة، ثم ينفصل عنه في حديثه اليومي، فيكون علمه مخزونًا لا متداولًا، محجوزًا في الأوراق لا متدفقًا في الحياة، وأما من أراد للمعرفة أن تترسخ في ذهنه، وأن تثمر في نفسه، فعليه أن يجعلها جزءًا من لغته اليومية، يناقش بها زملاءه، ويطرح مسائله العلمية في حديثه، ويسأل، ويُجيب، ويستدرك، ويناظر، حتى يصير العلم مألوفًا في لسانه، متغلغلًا في تفكيره، حاضرًا في وعيه دون تكلّف. |
|
وربما كانت الكلمات العابرة أعمق تأثيرًا من دروس المطولات، والمناقشة العفوية قد تُثبت في الذهن ما لم تُثبّته ساعات المطالعة، ومن أدخل العلم في حديثه اليومي، لم يظل مجرد متلقٍّ ساكن، بل صار نافذ الأثر، يبعث في بيئته روح الفكرة، ويغرس بذور المعرفة، ويعيد للمجالس نبضها الحيّ، فإن هي خلت من العلم، سادها الهزال، وانسابت إليها السطحية، وتحولت إلى فراغٍ يستهلك الأعمار دون طائل. |
|
19- تقليل مساحة القرار اليومي |
|
التردد استنزاف، وما أكثر اللحظات التي تذوب في دوامة التفكير قبل الفعل، حيث يتردد المرء بين خياراته اليومية، ويستهلك طاقته الذهنية في قرارات صغيرة تتكرر كل يوم، دون أن يدرك أن هذا النزيف الصامت يقتطع من تركيزه، ويقلل من كفاءة سعيه في الأهم والأبقى، وكم من طالب علم أضاع ساعاته الأولى وهو يتساءل: ماذا أقرأ اليوم؟ بأي كتاب أبدأ؟ أي مسألة أبحث فيها؟ وكم من وقتٍ ذهبت دقائقه في التردد، حتى انتهى الأمر بفتور العزيمة، وانطفاء جذوة السعي؟ والمخرج من هذا التيه واضحٌ لمن تدبره: تقليل مساحة القرار اليومي، وتنظيم الاختيارات مسبقًا، بحيث تُختزل عملية التفكير المستمر في جدولٍ واضحٍ، يحدد ما يقرأه، ومتى يذاكر، وكيف يسير يومه، فلا تُستهلك طاقته في التردد، بل تُحشد في الإنجاز. |
|
وهذا لا يقتصر على طلب العلم، بل هو قاعدة في تدبير الحياة، فإن كل قرارٍ يتخذه الإنسان، مهما بدا صغيرًا، يستهلك من رصيده الذهني، حتى لو كان أمرًا يسيرًا كاختيار الملابس أو ترتيب أولويات اليوم. ولذا، فإن النفوس الكبيرة تحسم التردد في الأمور الصغيرة، ليتفرغ الذهن لما هو أعظم وأثقل في الميزان، فطالب العلم الذي يُحسن تنظيم يومه، ويضبط مساره بجداول محددة، يكون قد اختصر على نفسه طريقًا طويلًا من الإرهاق الذهني، وفتح لنفسه باب التركيز الصافي، حيث لا تُستنزف همته في دوائر التردد، بل تُسدد خطاه إلى مقاصد العلم والعمل بثباتٍ ويقين. |
|
20- العلم ينمو بالبذل |
|
ليس العلم كومةً من المعلومات تُكدّس في الذهن، لا يثبت في القلب إلا إذا شاع وانتشر، فمن أسرّ علمه ولم ينشره، كان كمن أمسك بالماء بين كفيه، لا يلبث أن يتسرّب منه دون أن يشعر، ولهذا كان التعلم بالتدريس من أنجع الوسائل لترسيخ الفهم وتثبيت المحفوظ، فمن أدرك مسألةً فقهية، فليجعلها حديث مجلسه مع أهله، ومن قرأ حديثًا، فليجرّب أن يلخصه ببيانٍ واضحٍ، يذيعه بين أصحابه، ومن وعى فائدةً علمية، فليحرص أن ينقلها لمن حوله، فإن ذلك يُحكمها في ذهنه، ويفتح له أبوابًا جديدةً من الفهم والاستدراك، فالعلم كالشجرة، لا يشتدّ ساقها إلا إذا امتدت أغصانها، ومن اقتصر على الأخذ دون بذل، فلن يطول مقام العلم في صدره، ولن يدرك مواضع النقص في فهمه. وإذا كان بعض الناس يرون أن العلم يضيع بالنشر، فإن الحقيقة أن العلم يذبل بالكتمان، وينمو بالبذل. |
|
21- بركة الدعاء |
|
للدعاء سرٌّ لطيفٌ لا تحيط به الحسابات، ولا تفسّره المعادلات، فهو من سنن الله الخفية في تدبير الأمور، يفتح به على عباده من خزائنه ما لا تبلغه أسبابهم، ويهيّئ لهم من الفتوحات ما تعجز عنه قدراتهم، في عالم الأسباب، تسير الأمور وفق معادلاتٍ مرصودة، لكن في عالم العبودية، يتدخل الدعاء ليختصر الطريق، ويطوي المسافات، ويمنح العبد من التوفيق ما لا تبلغه حيلته ولا سعيه، وليس أدلّ على ذلك من العلم، فهو من أشرف الأرزاق التي لا تُنال بكثرة الذكاء وحده، بل هي منحةٌ إلهيةٌ يُختص بها من أخلص في طلبها، وأحسن التوجه إلى الله في رجائها، وقد صدق الإمام أحمد بن حنبل حين قال: " العلم عمائم يُسْقِطُها الله على رأس من يشاء فسلوا الله العلم النافع والعمل الصالح" فليس كل من قرأ وعكف بلغ، وليس كل من اجتهد فُتح له، بل هي أسرار تُبث في قلوب الصادقين، ممن تعلقت نفوسهم بالمدد الإلهي قبل أن تتعلق بجهدهم وكدحهم، فإذا رأيت عالمًا مُلهمًا، أو فقيهًا نافذ البصيرة، فابحث عن سجداته في جوف الليل، وتأمل في دعائه بين يدي مولاه، فإن الفتح الحقيقي لا تصنعه الأوراق وحدها، وإنما تصنعه النفوس التي وقفت على باب الله، تلتمس منه عطاءً لا يحدّه عقلٌ، ولا يقيسه منطق. |
|
الخاتمة: موازنةٌ لا مهادنة |
|
معركة التوفيق تعني ترتيب الأولويات، وموازنة المسؤوليات، وكبح الملهيات، حتى لا يذهب العمر بين وظيفةٍ تحكم قبضتها، وطلبٍ للعلم لا يجد في القلب موضعًا، فالمقصود ليس هجر العمل، ولا الاكتفاء بساعات الطلب المتقطعة، بل بناءُ حياةٍ يكون فيها الكسبُ في اليد، والعلمُ في القلب، فلا يطغى أحدهما على الآخر، ولا يُسلب أحدهما حقَّه. |
|
ومن فقه هذا الباب، علم أن الحل ليس في الانسحاب، بل في إحكام الموازنة، وتقليل الالتزامات غير الضرورية، واستثمار المواسم العلمية، والتدرج في التحصيل، ليُحسن السير في دربٍ قد سار فيه كثيرون من قبله، فجمعوا بين معاشهم ومعادهم، ولم يكونوا أسرى لأحدهما دون الآخر، فالتحدي الحقيقي ليس في إيجاد الوقت فحسب، بل في ضبط الهمم، وفي تحديد المقاصد، وفي الحذر من أن تكون السنوات مجرد جولاتٍ بين الأعمال الدنيوية دون أثرٍ يبقى، أو علمٍ ينفع، أو زادٍ يحمله المرء إلى آخرته، وهكذا يمضي العبد بين دروب الحياة، يتقلب بين أعباء السعي وثقل التكاليف، يجاهد في طلب العلم، ويكدح في تحصيل الرزق، مستمسكًا بيقينٍ لا يتزعزع بأن الأرزاق مكتوبة، وأن الله لم يأمرنا بالانهماك في الدنيا حتى نُذهل عن الآخرة، ولا بالانقطاع للآخرة على حساب ضرورات العيش، فالتوازن هو ناموس العبودية، حيث لا إفراط ينهك الروح، ولا تفريط يُسقط العبد في وهدة التواكل. |
|
والمرء يحتاج إلى بصيرةٍ تحفظ له ميزانه، فلا تغلبه زخارف الدنيا حتى تستعبده، ولا يفرّ منها فرارًا يوقعه في مذلة السؤال، فإن من تمام التوكل أن يسأل العبد الله زادًا يكفيه، ورزقًا يغنيه، فينال طمأنينة القلب بعيدًا عن ذلّ الحاجة، فلا يمدّ يده إلا لخالقه، ولا يعلّق أمله إلا بمولاه، ومن تأمل أدعية الصالحين، وجدهم يسألون الله كفافًا يغنيهم، وزهدًا لا يحوجهم، كما كان سفيان الثوري يدعو: "اللهم زهِّدنا في الدنيا، ووسِّع علينا منها، ولا تزُوها عنا فترغّبنا فيها[14]." فإن العبرة ليست في كثرة المال أو قلته، وإنما في حرية القلب من عبوديته، وامتلائه بغنى النفس، حيث يكون الرزق في اليد، لا في الفؤاد. |
|
______________________________________________________________________________ |
|
[1] صيد الخاطر – ابن الجوزي - 315 |
|
[2] الجامع لأخلاق الراوي، للخطيب البغدادي: (1/98) |
|
[3] أدب الدين و الدنيا – الماوردي – 37 |
|
[4] ذيل طبقات الحنابلة - لابن رجب - ت العثيمين ١/٣٢٤ |
|
[5] صيد الخاطر ١/٢٤١ — ابن الجوزي |
|
[6] سورة القصص – الآية 77 |
|
[7] حلية طالب العلم – د.بكر أبو زيد – 171 |
|
[8] التخريج : أخرجه البخاري (6465)، ومسلم (783) واللفظ له. |
|
[9] حلية الأولياء وطبقات الأصفياء – أبي نعيم -6/363 |
|
[10] جامع بيان العلم 1/431 |
|
[11] تهذيب التهذيب – ابن حجر -5/480 |
|
[12] المدخل، لابن الحاج العبدري (٣/١) |
|
[13] تذكرة السامع و المتكلم -ابن جماعة- 117 |
|
[14] موسوعة ابن أبي الدنيا ٥/ ٩٤ |
نشرة توّاق البريدية
هذا البريد خيطٌ رفيعٌ يربطني بما يستحق أن يُحفظ في الذاكرة، فليس مجرد سطرًا في قائمة، ولا إشعارًا ينطفئ مع الوقت، بل هو لحظة توقّف وسط الركض، ومجال للتأمل في عالمٍ لا يكفّ عن الاندفاع.



التعليقات