نــشــرة فــهــرس تــشــريــعــي - الــعــدد (3) | الإغـــفـــال الــتــشــريــعــي |
|
|
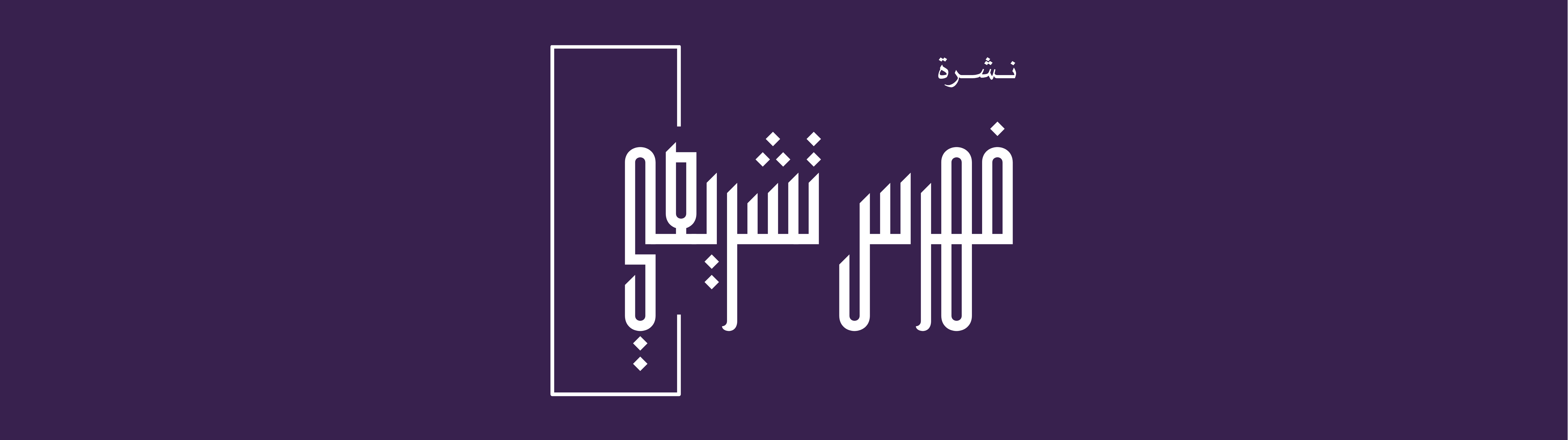
|
|
تعريف | |
|
يُعرّف الإغفال التشريعي بأنه الحالة التي يكون فيها تنظيم القانون لمسألة معينة لا يتوافق مع ما ينبغي أن يكون عليه وفقًا للقواعد والمعايير العامة للقانون، أو هو إغفال المُنظِّم جانبًا من جوانب الموضوع محل التنظيم مما يؤدي إلى الحد من فعاليته وقصوره.* |
|
*منقول بتصرّف عن: مها سعد الصالح، بحث بعنوان: "الإغفال التشريعي في المملكة العربية السعودية: دراسة تحليلية مقارنة"، المجلة الأكاديمية للأبحاث والنشر العلمي. |
|
لـمـاذا وَكـيـفَ وَمَـتـى؟ | |
|
تكمن خطورة الإغفال التشريعي في كونه يضرب مبدأ الأمن القانوني، ويقوّض الثقة في المنظومة القانونية بأكملها. فعندما يغفل المُنظِّم عن تنظيم حق أو وضع آلية لتطبيقه، فإنه يتحوّل هذا الحق من ضمانة دستورية فعلية إلى مجرد نص نظري لا قيمة عملية له، مما يخلق حالة من عدم اليقين ويعطل الحقوق والحريات، بل وقد يحدث أزمات قانونية وعملية حقيقية. وفي هذا السياق من الضروري التمييز الدقيق بين صورتين رئيسيتين للإغفال التشريعي، لما يترتب على هذا التمييز من آثار مهمة في نطاق الرقابة القضائية: |
|
1. الإغفال الجزئي (القصور التشريعي): يتحقق هذا النوع عندما يتدخل المُنظِّم بالفعل لتنظيم موضوع معين، ولكنه يغفل عن تنظيم جانب جوهري منه أو حالة محددة كان يجب أن يشملها التنظيم لتحقيق غايته الدستورية. في هذه الحالة، يكون التشريع موجودًا، ولكنه معيب بالقصور والنقص. وقد أشارت المحكمة الدستورية العليا في مصر إلى هذا النوع بعبارات مثل "عدم تضمين أحكام كان يجب أن تتضمنها المادة المتنازع عليها". وهذه الصورة هي الأكثر قبولًا لدى الفقه والقضاء لإخضاعها للرقابة الدستورية، لأن القاضي لا يحل محل المُنظِّم، بل يكمل نقصًا في عمل قائم بالفعل. |
|
2.الإغفال الكلي (السكوت التشريعي): يتحقق هذا النوع عندما لا تنظم السلطة التنظيمية موضوع معين أوجب عليها الدستور تنظيمه، فتترك فراغًا تشريعيًا كاملًا في هذا النطاق. ويثير هذا النوع جدلًا فقهيًا وقضائيًا واسعًا حول مدى جواز الرقابة عليه، حيث يرى البعض أن التدخل فيه يمثل مساسًا بالسلطة التقديرية للمنظّم في تحديد أولوياته وتوقيتات تدخله التشريعي، بينما يرى آخرون أن هذا السكوت قد يشكل إخفاقًا دستوريًا يستوجب الرقابة لضمان تفعيل الحقوق الدستورية. |
|
لذلك ولمعالجة هذا الإغفال، تتنوع الآليات بين المعالجة اللاحقة التي يقوم بها القضاء، والمعالجة الوقائية التي تقع على عاتق السلطة التنظيمية. |
|
فمن جهة، تطور القضاء الدستوري المقارن في التصدي للإغفال التشريعي، وتبلورت ممارساته في عدة صور من الأحكام القضائية التي تهدف إلى تصحيح هذا العيب الدستوري، كالأحكام الكاشفة، أو الإيعازية، أو الحكم بعدم دستورية النص المنطوي على الإغفال، أو حتى الأحكام المضيفة التي يكمل فيها القاضي ما أغفله المُنظِّم. وفي السياق السعودي، ورغم عدم وجود آلية قضائية دستورية مباشرة مشابهة، إلا أنه قد تكون لدعوى الإلغاء أمام القضاء الإداري (ديوان المظالم) دور في الرقابة على مشروعية القرارات الإدارية اللائحية (اللوائح التنفيذية التي تصدر من السلطة التنفيذية) التي قد تتضمن قصورًا تنظيميًا. فمثلاً، جاء في أسباب الحكم الصادر في القضية لدى محكمة الاستئناف الإدارية برقم (7327) لعام 1439هـ، ما يؤكد الرقابة على المشروعية هنا وبما نصه: (فإنه وإن كانت اللوائح الإدارية الصادرة بقرار إداري تتحصن من الإلغاء بمضي المدة، وإن انطوت على عيوب فيها، غير أن هذا التحصن لا يسبغ عليها المشروعية من جميع الوجوه (...) فإن لأصحاب الشأن في حال صدور قرار ضدهم بناء على لائحة معيبة أن يتقدموا بدعوى بالمطالبة بإلغائه، ولو كانت هذه اللائحة قد تحصنت من الإلغاء، مستندين في ذلك إلى عدم مشروعيته). كما أن مواجهة السكوت الكلي من قبل الإدارة يجد طريقه عبر دعوى إلغاء "القرار الإداري السلبي"، وهو امتناع الجهة الإدارية عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه نظامًا. |
|
ومن جهة أخرى، وهي الأهم، تأتي المعالجة الوقائية التي تمنع وقوع الإغفال من المنبع. وفي هذا السياق، يبرز "الدليل الإرشادي لصياغة مقترح تشريعي لنظام أو لائحة" الصادر في المملكة العربية السعودية كآلية تضع منهجية علمية وعملية من اثنتي عشرة مرحلة تتكامل لإدارة المخاطر التشريعية. تبدأ هذه المنهجية من الخطوة الأولى بتكليف الجهات الحكومية بدراسة الوضع الراهن وتحديد ما إذا كان الهدف هو "سد فراغ تشريعي" قائم، وتستمر عبر خطوات وقائية محددة تشمل حصر التشريعات القائمة، ودراسة التجارب الدولية، وتحديد نطاق التشريع بدقة، والتحقق من اتساقه مع المنظومة القانونية، والنص الصريح على أحكام الإلغاء والأحكام الانتقالية*. وبهذه المنهجية الشاملة، يصبح الدليل أداة فعالة لتحديد ومعالجة الفجوات المحتملة قبل أن تتحول إلى إغفال تشريعي يستدعي تدخلاً قضائياً، مما يعزز من جودة التشريع ويحقق الأمن القانوني بشكل استباقي. |
|
ومع تسارع وتيرة الابتكار وظهور تقنيات ونماذج عمل جديدة، خاصة في مجالات التقنية المالية والتجارة الإلكترونية، يبرز تساؤل حول كيفية مواكبة التشريع لهذه المستجدات. هنا، تظهر آلية مبتكرة لمعالجة الإغفال التشريعي المحتمل في هذه القطاعات وهي: "البيئة التجريبية التشريعية". وقد أطلق البنك المركزي السعودي "ساما" وهيئة السوق المالية هذه البيئة كفضاء يسمح للشركات باختبار منتجاتها وخدماتها المبتكرة في بيئة حية وتحت إشراف مباشر من الجهة التنظيمية. وبهذا، يتحول الإغفال التشريعي من كونه تحديًا إلى فرصة للتعلم المشترك، حيث تتمكن الجهات التنظيمية من فهم التقنيات الجديدة ومخاطرها قبل صياغة تنظيمات دائمة، مما يضمن مواكبة التشريع لمتطلبات المستقبل وتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030. |
|
*سيتم تناول مصطلح (الأحكام الانتقالية) في العدد رقم (15) من النشرة إن شاء الله. |
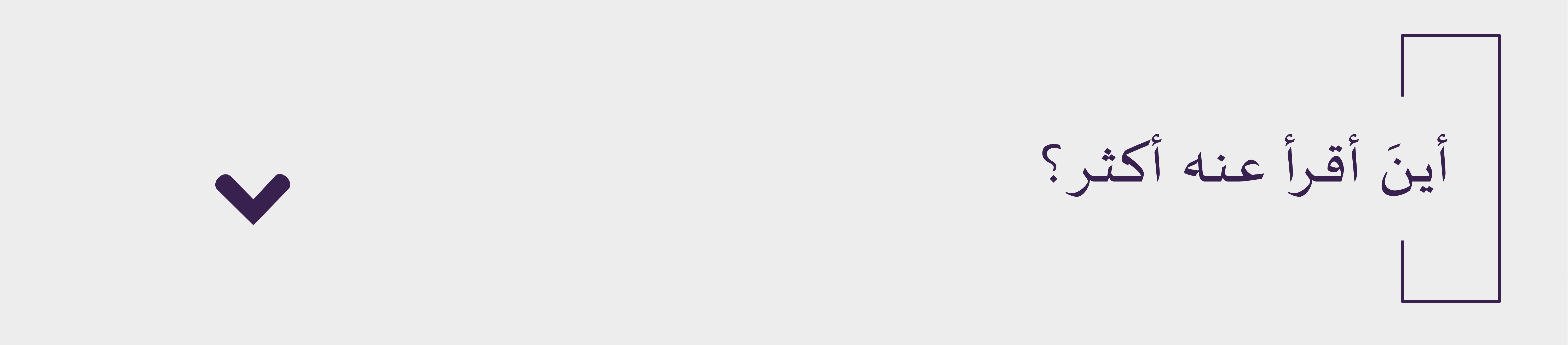
|
|
1) مها سعد الصالح، بحث بعنوان: "الإغفال التشريعي في المملكة العربية السعودية: دراسة تحليلية مقارنة"، المجلة الأكاديمية للأبحاث والنشر العلمي. (انقر هنا). |
|
2) وائل خالد محمد قاسم، "إشكالية الإغفال التشريعي في النظم القانونية المقارنة"، المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية). (تحليل مقارن لأبعاد الإشكالية). (انقر هنا). |
|
3) هشام محمد الفرارجي، "الرقابة على الإغفال التشريعي: دراسة مقارنة"، المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية). (يركز على آليات الرقابة القضائية). (انقر هنا). |
نشرة فهرس تشريعي البريدية
نشرة فهرس تشريعي تتناول في كل عدد منها "مصطلح" أو "مبدأ" يتعلقّ بعلم صياغة التشريعات، من خلال الجمع والتحليل للمصادر المختلفة للإجابة عن (5) أسئلة رئيسية هي: ما هو؟، لماذا وكيفَ ومتى يُستخدم؟، وأينّ يُمكن أن أقرأ أكثر عنه. ويُرجى ملاحظة أن بعض تلك المصطلحات والمبادئ لا تزال مُستحدثة ولا تعريف واضح لها في الممارسة في المملكة، وعليه فإن ما سيرد بشأنها في النشرة يُعد خُلاصة تجربة أو تحليل للوصول إلى تعريف وإجابة بشأنها على كل سؤال من الأسئلة أعلاه.
التعليقات