لا تعطه سمكة، علّمه الصيّد، ولكن ليكن هناك بحر قربه أولاً .. |
| 19 أكتوبر 2025 • بواسطة د. فادي عمروش • #العدد 151 • عرض في المتصفح |
|
المهارة دون سياق تُشبه بوصلة بلا خريطة؛ لا تهدي سبيلاً ولا تفتح أفقًا
|
|
|
|
في زمن تتسارع فيه التغيّرات الاقتصادية والتقنية والاجتماعية، لم تَعُد مجرّد المهارة كافية لضمان الاندماج الفعّال في سوق العمل. فكما تقول الحكمة الشائعة: «لا تُعْطِه سمكة، علّمه الصيد»، غير أنّ هذه المقولة تبدو منقوصة إن لم نجد "بحرًا" يصطاد فيه المتدرّب. فالمهارة دون سياق تُشبه بوصلة بلا خريطة؛ لا تهدي سبيلاً ولا تفتح أفقًا. من هنا، تبرز أزمة جوهرية في منظومات التعليم والتدريب التي تُنتج "خبراء" قبل أن تُحدّد أين يمكن استثمار خبراتهم. |
غاية التعليم: من المعرفة إلى الفعل |
|
كل منظومة تعليمية أو تدريبية تنطلق من افتراض فلسفي أساسي، يُعرف في الفكر الإغريقي بمفهوم «التيلوس» (Telos): أي الغاية. هذه الغاية هي تحويل المعرفة إلى قدرة فعّالة تُحدث أثرًا ملموسًا في الواقع. لكن حين يتم تعليم مهارات لا يطلبها السوق، تصبح هذه المعرفة عبئًا لا أداة، وتنتج ما يمكن تسميته بـ«القدرات المعطّلة»؛ أي كفاءات لا تجد موضوعها ولا موطئ قدم لها. |
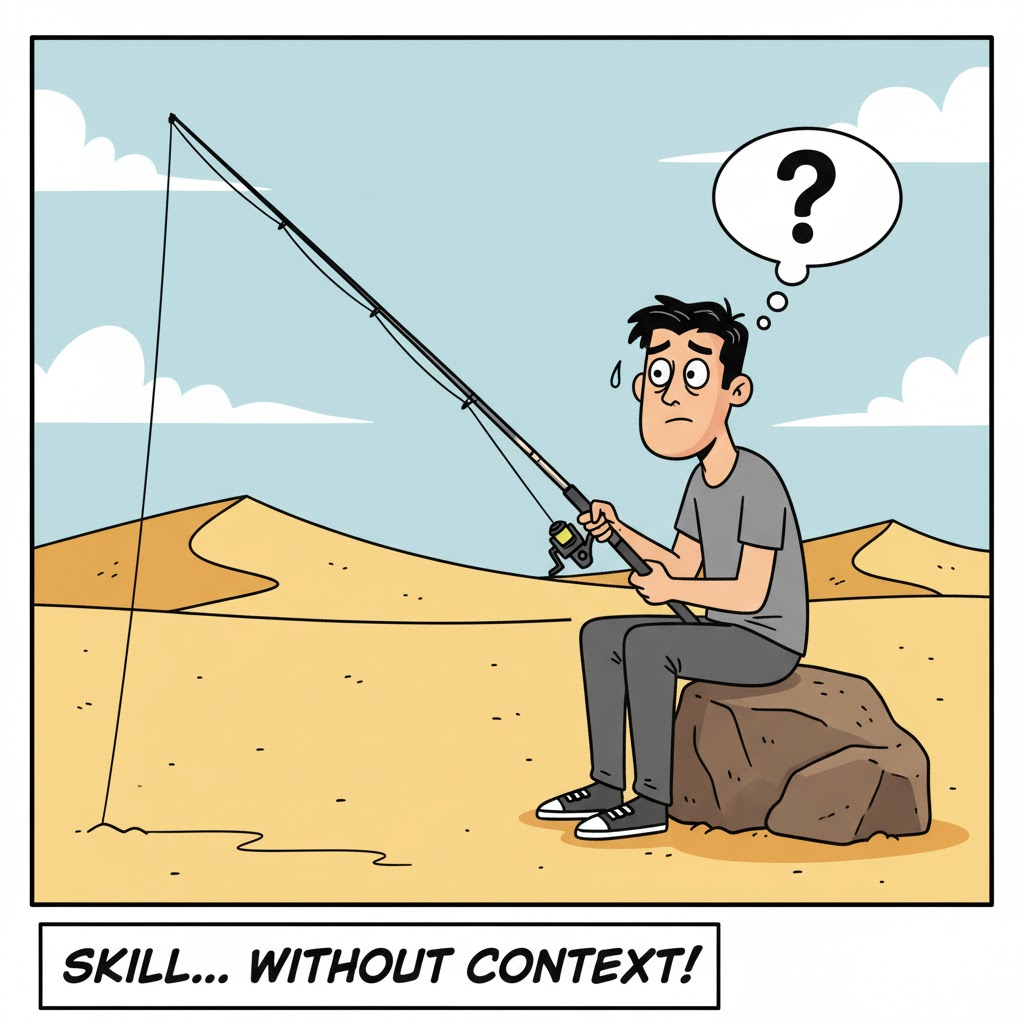
المهارة بدون سياق، كالصيد في الصحراء .. |
ثلاث مشكلات جوهرية |
|
هذا الانفصال بين المهارة والسياق يخلّف آثارًا عميقة على مستويات عدّة: |
|
لماذا يحدث هذا الخلل؟ |
|
ترجع جذور الأزمة إلى عدد من الأسباب البنيوية: |
|
نحو مقاربة فلسفية عملية |
|
لمعالجة هذا الخلل البنيوي، لا يكفي إصلاح الأدوات، بل ينبغي إعادة التفكير في الفلسفة الكامنة وراء التعليم والتدريب. وهنا يمكن الاستفادة من ثلاث مقاربات فلسفية حديثة: |
|
خلاصة |
|
لا يكفي أن نُعلّم الصيد، بل لا بد من أن نرسم خريطة البحار، وأن نُتيح الوصول إليها. إصلاح منظومة التعليم والتدريب يبدأ من سؤال الغاية: لماذا نُعلّم؟ ولمن؟ وفي أي سياق؟ فحين يُصبح التعليم متّصلًا بحاجة المجتمع، ويُقاس بمعياره الواقعي، لا الرمزي، آنذاك فقط يمكن القول إننا نُنتج "قدرة" لا مجرّد "شهادة". |
نشرة خارج الصندوق البريدية
نشرة دورية تصدر كلّ يوم سبت، يصدرها د. فادي عمروش تتضمن فكرة خارج الصندوق مع اغناءها بالروابط وما بين الكلمات، لتقول وجدتّها


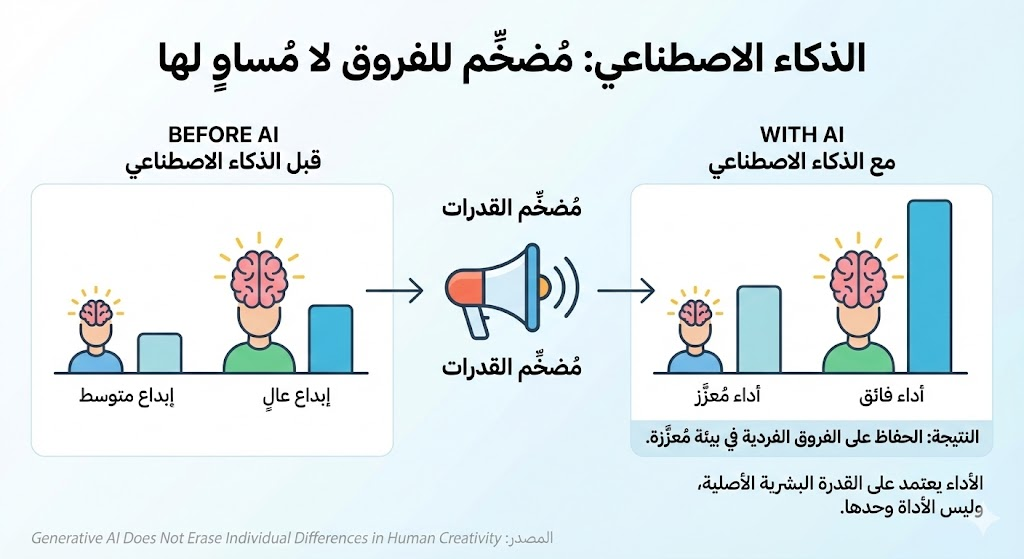
التعليقات